الرسم التوضيحي: PV |
توفيت والدتي وأنا طفل صغير. عمل والدي عامل بناء في سايغون، ولم يكن يزورنا إلا مرة كل بضعة أشهر. كانت طفولتي بأكملها تُشبه ظل لان حول المدفأة، وصوت نداءها للدراسة على ضوء مصباح الزيت المتوهج، وأمسيات الصيف عندما كانت تذهب إلى الحقول لجمع الأرز، تلتقط كل حبة متساقطة، وتجففها على قماش مشمع ملطخ في وسط الفناء.
عندما كنت في العاشرة من عمري، كانت لان في الثامنة عشرة أيضًا - سن الأحلام والأمل. كانت قد أنهت لتوها امتحان القبول بالجامعة، حاملةً معها أحلامها الكثيرة بالذهاب إلى الجامعة التي راودتها طوال سنوات دراستها الثانوية. كانت نهاية أغسطس، وحقول الأرز أمام المنزل تكتسي بلون أصفر ذهبي، وأشعة الشمس الجافة تنتشر على كل ساق أرز ناضجة منحنية، تفوح منها رائحة عطرة. في فترة ما بعد الظهر، بعد الطبخ وغسل الملابس، كانت تجلس تحت شجرة مانجو عتيقة، تمشط شعرها الأسود الطويل كالحبر، وأشعة الشمس تسقط على كل خصلة من شعرها، تلمع كحرير سماوي. جلست بجانبها، أتمتم بجداول الضرب، بينما كانت تغني بصوت خافت، وصوتها صافٍ كصوت الريح في الحقول.
أحبت لان الدراسة. منذ طفولتها، ومهما كانت عائلتها فقيرة، لم تتغيب يومًا عن المدرسة. في إحدى المرات، عندما هطلت أمطار غزيرة ووصل منسوب المياه إلى ركبتيها، سارت مسافة خمسة كيلومترات تقريبًا للوصول إلى المدرسة. في ليالي الشتاء، عندما كان الجو قارس البرودة وعوي الرياح عبر جدران الخيزران، أشعلت مصباحًا زيتيًا ودرست حتى وقت متأخر من الليل، ويداها أرجوانيتان، لكنها استمرت في تدوين الملاحظات بجد. ربما كانت الكتابة بالنسبة لها هي السبيل الوحيد للخروج من دوامة الفقر.
ثم يوم إعلان نتائج الامتحانات، لم يكن اسمها مدرجًا في الإعلان. في ذلك الوقت، كان المطر قد بدأ للتو. لم يكن المطر في الغرب غزيرًا، بل مستمرًا، هادئًا كتنهيدةٍ مُخبأةٍ في القلب. في ذلك المساء، جلست شارد الذهن على الشرفة، وورقة الامتحان مُجعّدة في يدها. لم أعرف ماذا أقول، فجلست بهدوء بجانبها، أُعطيها بطاطا حلوة مسلوقة ساخنة.
ابتسمت بشكل ملتوٍ:
- لا بأس. خذها مرة أخرى العام القادم...
في ذلك المساء، اتصل بي والدي. كان صوته غائمًا كقطرات الندى الأولى في الموسم:
إذا فشلتَ، فاعمل. إذا بقيتَ في المنزل طوال الوقت، فمن سيطعمك؟
أغلق الهاتف، ولم تقل شيئًا. طوّت بهدوء دفتر ملاحظاتها القديم - الذي كانت تكتب فيه مذكراتها ومقالاتها - ووضعته بعناية في الصندوق الخشبي. سمعتُ صوت إغلاق غطاء الصندوق، جافًا وحاسمًا. في تلك الليلة، بينما كنتُ مستلقيًا متظاهرًا بالنوم، سمعتُ تنهدها الخافت. لم يكن هذا التنهد من حلقها، بل بدا وكأنه قادم من أعماق قلبها، طويلًا، لا ينتهي، باردًا كصوت صفير الريح عبر سقف من القشّ مثقوب.
* * *
في العام التالي، خلال موسم الفيضان، عندما عادت أسراب البط البري لتغطي حقول الأرز التي لم يُحصَد منها نصف الحصاد، حزمت لان حقائبها وتوجهت إلى المدينة. قالت:
أعمل عامل مصنع. أدخر المال حتى لا أضطر للانقطاع عن الدراسة مثلك بعد التخرج.
غادرت مسقط رأسها في صباح كئيب، والسماء مغطاة بطبقة من السحب الرمادية، كما لو كانت تكبح خطوات فتاة لم تسافر بعيدًا قط. وقفتُ على الشرفة، حاملًا حقيبتي المدرسية الممزقة، أشعر بوخزة في قلبي. منذ وفاة والدتي، لم أشعر قط بفراغ منزلي إلى هذا الحد.
في بداياتها في سايغون، كانت رسائلها إلى الوطن قليلة ومتباعدة. كانت تعمل في مصنع ملابس صناعي، حيث كان العمل شاقًا وساعات العمل الإضافية متواصلة. لم يكن راتبها مرتفعًا، لكنها كانت تدّخر المال لإرسال الكتب إليّ. حتى أنها أرسلت لي ذات مرة رسالةً فيها بضعة أسطر غشيتها الدموع:
أنا بخير. ابقَ في المنزل وادرس بجد. لا تدع الفقر يُعيقك.
نشأتُ مع كل موسم فيضان، ومع كل مرة كانت حافلة الركاب تجوب الطريق السريع المُغبر ذهابًا وإيابًا. في بداية كل عام دراسي، كانت تُرسل لي قميصًا أبيض نظيفًا، أو زيًا يُناسب قوامي النحيل. أحيانًا كنتُ أتمنى لو كانت في المنزل، يكفيني الأرز والخضراوات. لكنني فكرتُ حينها، لولاها، لما استطعتُ الذهاب إلى المدرسة على الأرجح.
كان لدى لان حبيبٌ في إحدى السنوات عندما احتفلت المدينة بعيد رأس السنة القمرية مبكرًا، عندما بدأت أزهار المشمش الصفراء تتفتح على شرفات المنازل. كان مهندسًا كهربائيًا، يعمل بالقرب من منزلها الداخلي. قالت بصوتٍ منخفضٍ وهادئٍ كدخان المساء:
- صور جيدة، تعرف كيف تشارك، أنا حقا أحبك.
كانت تلك أول مرة أراها غارقة في أحلام اليقظة هكذا. أشرقت عيناها عندما تحدثت عنه، وازدادت ابتسامتها خلال المكالمات الهاتفية المتسرعة. كنت سعيدًا سرًا، آملًا أن تجد شخصًا يستحق السنوات التي ضحت بها في صمت.
لكن الأمور لم تكن هادئة كرياح مارس. عندما أخبرتني أنها تريد اصطحابه إلى المنزل للقاء والديها، هدر والدي على الهاتف:
- النساء في الريف، العاملات، لا يحلمن بالصعود إلى أعلى. أنا لا أقبل بذلك.
جادلتني، لأول مرة أسمع صوتها بهذه القسوة. ثم صمت الهاتف. بعد بضعة أسابيع، عادت إلى المنزل وحدها، ترتدي ملابس بسيطة، وعيناها حمراوين. قالت إنه في رحلة عمل بالخارج. لم أصدقها، لكنني لم أجرؤ على سؤالها أكثر. في ضوء ظهيرة ذلك اليوم الرمادي الفضي، جلست لان تحتضن ركبتيها على ضفة خندق جاف، وعيناها بعيدتان كما لو كانت تنظر إلى مكان لا ينتظر فيه أحد.
* * *
يتدفق الوقت كالنهر في موسم الجفاف، يُزيل بهدوءٍ حواف الذكريات الحادة. اجتزتُ امتحان القبول الجامعي، ووصل إشعار القبول يوم هطول أول مطر في الموسم. نقر الرذاذ على السقف الحديدي القديم المموج، مُصدرًا صوتًا كصوت فرحٍ مُنكسر. وقفت السيدة لان في المطبخ، ويداها لا تزالان مُغطاتين بدقيق الكيك، ركضت مسرعةً لتُحييني في الزقاق، مُمسكةً بورقة اسمي المطبوعة عليها كما لو كانت تُمسك بحلم. انهمرت دموعها على حواف الحروف الضبابية، ليس بالضرورة بسبب عاطفتها، ولكن لأن سنوات الصمت التي تركتها وراءها، بدت الآن وكأنها تتفتح في تلك اللحظة.
ذهبتُ إلى سايغون للدراسة، واستأجرتُ غرفةً قريبةً من مكان عمل أختي. كانت الغرفة الصغيرة ضيقةً لكنها دافئة، لأن أختي كانت دائمًا بجانبي، أختٌ كانت بمثابة الأم والصديقة، ونورًا لا ينطفئ في قلب المدينة الكبيرة. كانت تعمل في محلٍّ لفساتين الزفاف، وهو عملٌ يتطلب دقةً ونظرةً ثاقبة. في المساء بعد العمل، كانت تُدير ظهرها وتركب دراجتها في الشوارع المزدحمة، تُحضر لي كيسًا من الأرز اللزج الساخن، أو وعاءً من حساء الفاصولياء الحلوة، أو أحيانًا مجرد بطاطا حلوة مشوية عطرية. قالت:
حاول أن تدرس. المعرفة لا تُنتزع منك. في المدينة، لا تنجرف وراء الآخرين. أنهِ دراستك ثم فكّر فيما ستفعله لاحقًا.
درستُ. مرّت أربع سنوات من الجامعة في لمح البصر. مواسم الامتحانات المُرهقة، وليالي الأرق مع الكتب الدراسية الثقيلة، كان هناك دائمًا ظلها في مكان ما، أحيانًا صندوق غداء ساخن في انتظاري، وأحيانًا ظهر نحيل يتكئ على الباب يراقبني وأنا أدرس دون أن أقول شيئًا. في اليوم الذي حصلت فيه على وظيفتي الأولى، وراتبي الشهري الأول، مررتُ بمتجر أحذية، واخترتُ حذاءً ورديًا مسطحًا - وهو الطراز الذي كانت غالبًا ما تنظر إليه لكنها لم تشترِه قط. أمسكت الحذاء بيدها بتردد:
- لا يزال بإمكانك ارتداء الصنادل... احتفظ بها ولا تقلق بشأن المستقبل.
ثم ابتسمت، ابتسامة رقيقة مثل شمس أواخر الصيف، ولكنها دافئة بشكل غريب.
تزوجت لان وهي في الثلاثين من عمرها. لم يكن ذلك الرجل مهندسًا، ولا رومانسيًا، ولم يكن يُهديها الورود في الأعياد. كان مجرد نجار، بمظهره غير المهندم ويديه المتصلبتين، لكن عينيه كانتا صادقتين ودافئتين كخشب الماهوجني القديم. التقيتُ به لأول مرة في السوق، عندما كان يقود دراجته النارية القديمة، ويحميها من الشمس بقميص قديم. نظرتُ إلى عينيها في تلك اللحظة، فأيقنت أنها وجدت ملجأً لها.
كان زفافها بسيطًا كعادتها: بضع صواني طعام تحت أشجار المانجو خلف المنزل، وبضع أغانٍ في ظهيرة هادئة. عاد والدي أيضًا. لم يقل الكثير، بل ربت على كتفها برفق، كاعتذار متأخر بعد سنوات من اللامبالاة. كانت حماتها بائعة كعك الموز المقلي في السوق، صوتها عالٍ لكن شخصيتها صادقة، أحبتها كما لو كانت ابنتها.
تعيش الآن في الريف، في منزل صغير من غرفتين، بجوار حديقة خضراوات وبعض أشجار الموز. لديها طفلان، ولد وبنت، كلاهما ذكيان ومتألقان. في كل مرة أعود فيها إلى المنزل، يندفع الطفلان للخارج، ويتحدثان عن المدرسة والأصدقاء والأطباق اللذيذة التي تطبخها والدتهما. لا تزال تبتسم ابتسامة خفيفة، ويدها تقطف الخضراوات بسرعة، والأخرى تمسح العرق عن جبين طفلها.
في يومٍ ماطر، جلستُ أنا وأختي على الشرفة، نطلّ على القناة الموحلة. هبت الرياح عبر أشجار المانغروف، حفيفًا كصوتِ عودِ الزمن. سألت:
هل أنت متعب هناك؟ هل تفتقد أرز صلصة السمك المطهو الذي طبخته؟ ابتسمت:
- بالطبع أفتقدك. أفتقد الأرز، أفتقدك، أفتقد صوت المطر على سقف القش. لم تزد على ذلك، سكبتُ لي كوبًا من شاي الزنجبيل الساخن، وعيناها تلمعان برقة لن أنساها أبدًا.
جلستُ هناك، في منتصف بيت صغير على ضفاف قناة هادئة، أنظر إلى المرأة التي قضت شبابها من أجلي - الآن في سلام، ليست نبيلة بل ممتلئة، ليست صاخبة بل سعيدة. في الخارج، امتزج صوت الطيور بضحكات الأطفال، يمتزج مع الريح، ويغمر قلبي بشعور لا يوصف من الرقة. في ضوء الظهيرة الذهبي، أختي - ساكنة كحقل بعد عاصفة، هادئة، بسيطة لكنها فخورة، وهي أيضًا أهدأ شاطئ في حياتي.
المصدر: https://baophuyen.vn/sang-tac/202506/chi-toi-f3e2c97/






























































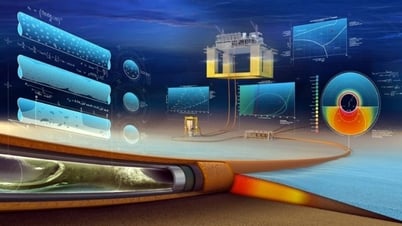




![[صورة] رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان يستقبل رئيس جمعية الصداقة المغربية الفيتنامية](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/26/b5fb486562044db9a5e95efb6dc6a263)



































تعليق (0)