
انضممتُ أنا وعمي تونغ إلى الجيش في نفس الوقت. يوم مغادرتنا، لم تكن الشمس قد أشرقت بعد فوق أشجار الخيزران. كان كل مكان لا يزال مغطى بطبقة سميكة من ضباب الصباح الباكر، معتمًا كالدخان. كانت مركبة عسكرية ، مموهة بشكل كثيف، متوقفة تحت شجرة قطن عند مدخل القرية لاستقبالنا.
خرج معظم الجيران لتوديع الجنود الجدد. حملت زوجتي ابنتنا ذات الخمسة أشهر إلى جانبها. وكان شقيقها ذو الخمس سنوات يمسك بي من رقبتي. تجمعت العائلة بأكملها مترددة في المغادرة. حاولت والدة العم تونغ، بظهرها المنحني قليلاً، رفع رأسها المرقط بالفضة، وفتحت عينيها الخافتتين الشبيهتين بفاكهة الونغان لتنظر عن كثب إلى وجه ابنها. حملت حقيبة الظهر بيد، وبالأخرى ربتت على ظهره، حاثةً إياه بقوة: "اذهب، يجب أن تكون قويًا، إخوتك ينتظرون في السيارة". تلعثمت في الجملة نفسها عدة مرات، وفمها يحثها، لكن ذراع العم تونغ كانت ممسكة بها بقوة.
كان ذلك في أوائل شهر مارس، وكانت شجرة الكابوك عند مدخل القرية قد اكتست بلون أحمر فاقع. من أعلى الشجرة إلى أغصانها الرقيقة المتدلية، كانت ألسنة اللهب المتلألئة تتدلى في كل مكان. هبت ريح نهر نغون عبر قمم الأشجار، فسقطت أزهار كثيرة على أرضية السيارة، وعلى قمم حقائب الظهر، وعلى أكتاف المجندين الجدد الذين ما زالوا يتلمسون طريقهم بزيهم الكاكي الجديد.
في كثير من الأحيان، كانت شجرة الكابوك في قريتي تنضم إلى القرويين في توديع أبنائهم للجيش بدموع الفرح في كل موسم إزهار. شعرتُ كما لو أن الشجرة تمتلئ بالحب أيضًا، وتتلوى لتنتزع من جذعها قطرات دم نقية طازجة تمنحنا القوة لخوض الحرب بثقة.
جلس العم تونغ بجانبي، ورفع يديه ليستقبل زهرة قطن لا تزال مبللة بندى الصباح، وضمها إلى صدره. تنفس أنفاسًا حارة في أذني، ثم قال جملةً طويلةً: "زهرة القطن تُسمى أيضًا زهرة القطن". كنت أعلم أنه يشتاق بشدة إلى زميلته في الصف الثاني عشر، مين.
سألتُ: "لماذا لم يأتِ مين ليودعني؟" كان صوته أجشًا: "كان دور مين اليوم في الخدمة، كان عليه أن يكون في البطارية من الرابعة صباحًا. الليلة الماضية كنا نبكي ونتحدث خلف شجرة القطن هذه. بعد منتصف الليل، عندما ودعنا، وضع مين في جيب قميصي قلم آنه هونغ وحزمة من ورق السيلوفان، ثم لفّ رقبتي فجأةً وعضّ كتفي بشدة.
تظاهرتُ بالبكاء: الدماء تغطي قميصكِ. شهقت: لا بأس! أتمنى أن تصبح ندبةً، لتتذكري مين دائمًا. عجزتُ عن إيجاد كلمات التشجيع، فلم أستطع إلا أن أمسك بيد تلميذ عمي، التي كانت ناعمة كالمعكرونة. قلتُ لنفسي في صمت: "ما زلتِ ضعيفةً جدًا، يجب عليكِ دائمًا دعمه وحمايته في كل المواقف الصعبة، أنا أعتمد عليكِ".
قبل مغادرة القرية، غرق قلبي في حنين الوطن. عندما انطلقت السيارة، سمعتُ شهقات مكتومة تحت ظل شجرة القطن العتيقة، التي كانت في أوج ازدهارها بأزهارها الجميلة. كان علينا أن نسيطر على مشاعرنا، وقفنا معًا، رافعين أيدينا، وهتفوا بصوت عالٍ: "نلتقي يوم النصر".
كان لجدي عشرة أشقاء. كان والد عمي تونغ أصغرهم. أنا أكبر من عمي تونغ بخمس سنوات. في عائلتي الكبيرة، كان من المعتاد دائمًا أن يُطلق من لديه عدة أطفال على أحد أبنائه في الصف الأخير لقب عم أو خالة. وهذا ما كان عليه الحال دائمًا.
توفي والد العم تونغ عام ١٩٤٨ في ليلة هجوم الجيش على حامية تام تشاو. كان عمره آنذاك أربع سنوات فقط. تولت والدته تربيته بمفردها منذ ذلك الحين. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية العام الماضي، ولأنه كان الوحيد من بين الشهداء، مُنح الأولوية للدراسة في الخارج في الاتحاد السوفيتي، وهو ما رغب فيه الكثيرون. رفض، وعضّ على طرف إصبعه، واستخدم دمه لكتابة رسالة عزم على التطوع للذهاب إلى ساحة المعركة للقتال ضد الأمريكيين. اضطرت والدته إلى توقيع الطلب لتأكيد موافقتها، ثم وافقت لجنة السياسات على تجنيده في الدفعة الأولى هذا العام.
عُيّنتُ أنا وعمي في نفس الفرقة. خضنا معارك عديدة معًا في ساحات معارك عدة مقاطعات في الجنوب الشرقي. بفضل بركات أجدادنا، لم أُصب أنا وعمي بشظية واحدة على مدار السنوات الأربع الماضية. لم نُصَب إلا ببضع نوبات من الملاريا وبعض الإصابات جراء انفجارات القنابل، ثم عادت صحتنا إلى طبيعتها.
في مارس/آذار الماضي، وبعد إعادة تنظيم الجيش، أُرسلتُ أنا وعمي تونغ من قِبل الوحدة لحضور دورة تدريبية خاصة مع عشرات الجنود من وحدات أخرى. عبرت مجموعتنا نهر سايغون سرًا وتوجهنا إلى القاعدة "ر". سافرنا ليلًا واسترحنا نهارًا تحت ظلال الغابة الشاسعة.
كان ذلك عام ١٩٧٠، وكانت الحرب في أشد مراحلها ضراوة. في تلك الليلة، كنا قد عبرنا للتو جدولًا جافًا عندما أصدر ضابط الاتصال الأمر التالي: "هذا القسم نقطة محورية تستكشفها طائرات العدو وتقصفها بانتظام، على الرفاق الانتباه جيدًا، وتجنبوا الانحياز".
سقط عدد لا بأس به من الضحايا هنا. كنت قد دفعت قبعتي المرنة للخلف، وكنت في حالة تأهب قصوى عندما سمعت عدة قذائف صاروخية تنفجر في السماء. اختبأت أنا وعمي بسرعة خلف شجرة قديمة على جانب الطريق. همس العم تونغ: "شجرة كابوك، شجرة قطن، يا صديقي!"
لمست اللحاء الخشن، ولمست راحتي الأشواك الحادة. تذكرت فجأة أشجار الكابوك في قريتي، التي لا بد أنها تزهر هذا الموسم. رفعتُ رأسي، فرأيت عددًا لا يحصى من أزهار الكابوك تتلألأ في الوهج، ثم تنطفئ لبرهة، كاشفةً عن مشاعل جميلة.
كان هناك غصنٌ في منتصف الشجرة، بحجم محراثٍ تقريبًا، انفجر بفعل قنبلة، وبدا كذراعٍ مُقطوعة تُشير إلى هلالٍ صاعدٍ في الأفق، مُتدليًا أيضًا بعناقيدٍ من الزهور المُبهرجة. بدا وكأن العم تونغ قد نسي في تلك اللحظة أمر الأعداء في السماء، واقفًا منتصبًا بحماس، وذراعاه تحتضنان نصف شجرة الكابوك، وهو يُطلق بحماسٍ بضع كلمات: "مين! مين! في قلب الغابة، توجد أيضًا أشجار الكابوك كما في مدينتنا يا عزيزتي".
فجأةً، لمعت برقٌ ساطع، لم أتمكن إلا من رؤية بعض البقع المضيئة تنعكس على عينيّ العم تونغ الواسعتين السوداوين. ثم خيّم ظلامٌ دامس. ثم ساد الصمت. صُمّت أذناي. انفجرت القنبلة على مقربةٍ شديدة، ودفعني ضغطها إلى أسفل، في الوقت الذي سقط فيه جسد العم تونغ بأكمله بثقلٍ على ظهري. تناثر الدم من صدره، ليغتسل قميصي، ساخنًا.
مات العم تونغ نتيجة قنبلة اخترقت قلبه، وخرجت من ظهره، وانغرست عميقًا في جذع شجرة الكابوك. قُشِعَت قطعة من اللحاء بطول عدة أيادٍ، كاشفةً عن جذع أبيض باهت. بين يدي، لم يستطع العم تونغ النطق بكلمة أخرى.
مين! مين! كان هذا آخر نداء لعمي في هذا العالم. بعد القصف، عادت الغابة إلى صمت مرعب. من الأعلى، انهمرت أشجار الكابوك بحزن كالمطر، غطتني أنا وعمي. كانت الأزهار كقطرات دم حمراء زاهية، ترفرف وتتساقط بلا نهاية.
وضعنا العم تونغ في حفرة عميقة حُفرت في الممر، على بُعد حوالي عشرة أمتار من قاعدة شجرة القطن. فتشتُ حقيبتي وغيّرتُ ملابسه إلى زي سوتشو الكاكي المطوي الذي كان يحتفظ به ليوم عودته من الشمال في إجازة. كما وضعتُ بعناية في جيب صدري الأيمن زجاجة بنسلين تحتوي على صورته والمعلومات الضرورية عن جندي مكتوبة على ظهرها.
وضعتُ بعناية ورق السيلوفان الملطخ بالدماء وقلم "هيرو" اللذين أهداه إياه مين في جيب قميصه الأيسر، حيث كان قلبه يقطر دمًا شبابيًا نقيًا. قبل أن نلفه بالبطانية، استخدمنا مصابيحنا اليدوية لنلقي عليه نظرة أخيرة.
كان وجهه شاحبًا من شدة النزيف، لكن زوايا فمه لم تكن قد انغلقت بعد، كاشفةً عن صفٍّ من الأسنان الأمامية المتناسقة كحبات الذرة، تلمع في الضوء. لم تتلاشى ابتسامته بعد، ابتسامة شبابية محفورة في ذاكرتي إلى الأبد. بدا وكأنه لم يختبر الألم بعد، ولم يكن يعلم أنه سيغادر هذا العالم في منتصف العشرينيات من عمره.
سقط أرضًا كما لو كان يرتمي في أحضان أمه، غارقًا في نوم عميق. بدون شاهد قبر، وجدنا حجرًا من اللاتريت مدفونًا تحت الأرض عند رأس القبر. عندما انتهينا، أحنى الفريق بأكمله رؤوسه في صمت وواصلوا المسير. ولأنه كان يعلم أنني ابن أخ العم تونغ، أخبرني ضابط الاتصال بلطف: "تقع شجرة القطن هذه على بُعد كيلومترين تقريبًا من جدول ثا لا الذي مررنا به للتو.
الطريق الذي سنمر به الآن هو نفس المسافة تقريبًا، خذه كإحداثيات". أما أنا، فقد ترددت عند قبره، أبكي وأدعو: "عمي تونغ! رحمك الله. هذه شجرة الكابوك، التي ستزهر موسمًا من الزهور الجميلة كل شهر مارس. إن روح الوطن وحب وشوق والدتك ومين وعائلتنا الممتدة مختبئة دائمًا في ظل هذه الشجرة، في أزهار مارس المتفتحة، التي ستدفئ روحك دائمًا خلال الأشهر والسنوات التي لا تزال تتجول فيها في هذا المكان. بعد يوم النصر، سآتي إلى هنا بالتأكيد لأعيدك إلى الراحة مع أسلافك، في قلب وطنك".
لم يبقَ من عمي إلا حقيبة الظهر الملطخة بالدماء التي كنت أحملها معي دائمًا خلال سنوات الحرب. في أول عودتي إلى المنزل في إجازة، تمالكت نفسي ووضعتها في صندوق خشبي مربوط بعارضة خشبية. كان من المؤلم جدًا بالنسبة لي رؤية أم تحمل تذكار طفلها الملطخ بالدماء.
بعد عودة السلام، أخبرتني زوجتي أن البلدية أقامت حفل تأبين للعم تونغ قبل عدة سنوات. توفيت عمتي مين أيضًا بعد عام من وفاة العم تونغ في ساحة معركة كوانغ تري . بعد توسلات متكررة من المنظمة وزوجتي، جاءت والدته لتقيم في منزلي بشكل دائم. كان منزلي بجوار منزلها، فكان من الملائم لها أن تعود إلى المنزل يوميًا لتحرق البخور أمام صورتين للشهداء الأعزاء.
لكنها كانت تظهر عليها علامات الخرف. كتبت زوجتي في رسالة: "كل صباح، كانت تذهب إلى مدخل القرية وفي يدها منجل وسلة، وتجلس شارد الذهن تحت شجرة الكابوك. وعندما يُسأل عنها، كانت تقول: أبحث عن بعض عشبة الخنزير لأساعدها وأطفالها. كما أنني أنتظر تونغ في طريقه إلى المنزل. بعد غيابه لسنوات طويلة، لا بد أنه نسي الطريق، يا له من أمر مؤسف!"
لم أحصل على إجازة شهر من وحدتي إلا في مارس ١٩٧٦. كنتُ جالسًا في القطار العسكري المتجه من الشمال إلى الجنوب، وكان بطيئًا كالسلحفاة. وبينما كنتُ أنظر إلى أشجار القطن المزهرة على جانبي الطريق، امتلأ قلبي بشوق لا ينتهي إلى العم تونغ.
كان الوضع آنذاك لا يزال معقدًا، ولم يسمح لي بالذهاب للبحث عن قبر عمي. كيف أخبر جدتي؟ نزلتُ في محطة مدينة نيو برونزويك عند منتصف الليل، وحملتُ حقيبتي على كتفي ومشيتُ، وعند الفجر وصلتُ إلى شجرة القطن عند مدخل القرية. كانت والدة عمي تونغ أول قريبة التقيتُ بها، وكانت في نفس المكان قبل أحد عشر عامًا. تشبثت بقميص عمي تونغ وحثته: "اذهب يا بني، ستكون ساقاك قويتين وحجارتك لينة. أصدقاؤك ينتظرون في الحافلة".
لم أستطع حبس دموعي، وأنا أعلم حالتها. أمسكت بيدها وأخبرتها باسمي. أسقطت المنجل والسلة، وعانقتني بشدة وبكت: "ذلك الابن البريء تونغ، لماذا لم يعد إليّ؟ لقد ترك أمه وحيدة وهزيلة هكذا. يا بني."
علمتُ أنها في حالة ذهول، فتظاهرتُ بأنني أطلب منها أن تأخذني إلى المنزل، قائلاً إنني نسيتُ البوابة. وكأنني استيقظتُ فجأةً، وبختني قائلةً: "يا والدك، أينما ذهبت، عليك أن تُخلّد ذكرى مدينتك، هذه هي طبيعة البشر. هذا أمرٌ سيءٌ للغاية." ثم أمسكت بذراعي مرةً أخرى، وهمست: "اذهب، يجب أن تكون قويًا وشجاعًا."
تمامًا كما لو كنتُ أمسك بيد العم تونغ ذلك الصباح. في ذلك الصباح، كان موسم إزهار أشجار القطن. كانت رياح نهر نغون لا تزال تهب عبر قمم الأشجار، وسقطت أزهار قطن كثيرة كدموعٍ بلون الدم على رأسي أنا وجدتي. كما لو كنا نتشارك، كما لو كنا نتعاطف.
واصلتُ مسيرتي العسكرية على خط المواجهة لحماية الحدود الجنوبية الغربية، ثم قاتلتُ ضد التوسعيين الشماليين. في عام ١٩٨٠، عندما ساد السلام، سُرِّحتُ من الخدمة. عندما عدتُ إلى المنزل ظهرًا، كانت زوجتي لا تزال في الميدان، ولم يكن أطفالي قد أنهوا دراستهم بعد. كان المنزل المكون من ثلاث غرف هادئًا ومهجورًا، لا تجلس فيه سوى زوجتي منحنيةً بجانب أرجوحة الجوت، بشعرها الأبيض الأشعث.
حقيبة الظهر المبللة بدم العم تونغ، التي أحضرتها من بضع سنوات مضت، كانت ملفوفة بعناية ووُضعت في الأرجوحة. أمسكت بحافة الأرجوحة بيد وحركتها برفق، بينما حركت مروحة سعف النخيل باليد الأخرى. تحدثتُ بهدوء، فرفعت رأسها وأسكتته بهدوء: "لا تتحدث بصوت عالٍ، دعه ينام. لقد عاد لتوه. لقد ضعفت قوة ابني، ومع ذلك فقد كافح في غابة القنابل والرصاص لسنوات عديدة. أشعر بالأسف الشديد عليه!" أشحتُ بوجهي سرًا لأخفي دموعي.
سألتُ زوجتي عن حقيبة ظهر عمي تونغ، فأوضحت: "أمرٌ غريبٌ جدًا يا عزيزتي. لعدة أيام، ظلت تُشير إلى الصندوق الذي ربطته بالعارضة وتبكي: تونغ في هذا الصندوق. أرجوك أنزله معي. أشعر بحزنٍ شديدٍ عليه. لم يعد هناك سبيلٌ لإخفائه عنها، لذا أنزلته، وبمجرد أن فتحته، احتضنت الحقيبة، تبكي بحرقةٍ من الحب. ومنذ ذلك الحين، توقفت عن التجول. كل يوم، كانت تجلس منحنية الظهر، تُهز الأرجوحة، وتهمس بأغاني حزينة."
بقيتُ في المنزل بضعة أيام. في ذلك الوقت، كانت والدة العم تونغ ضعيفة للغاية. نهارًا، كانت تُهزّ طفلها في أرجوحة، وفي الليل تتمتم في نفسها: "تونغ! لماذا لا تعود إلى أمي؟ جدي! لماذا لا تأخذني للبحث عن طريق للعودة إلى القرية؟ ما زلتُ صغيرة جدًا. جسد الطالب كغصن خيزران ضعيف. كيف أتحمل إرسالي إلى ساحة المعركة إلى الأبد يا صغيرتي؟"
بهذه الوتيرة، لن تعيش السيدة العجوز طويلًا. الطريقة الوحيدة للعثور على رفات العم تونغ وإعادتها إلى القرية هي مساعدتها على التعافي قليلًا. ما دمتُ لا أؤدي هذا الواجب المقدس، فسيثقل ضميري بالذنب لدرجة أنني سأنسى الأكل وأُعاني من الأرق.
بعد هذه الراحة القصيرة، قررتُ الانطلاق للبحث عن رفات عمي تونغ وجمعها لدفنها مع والده في مقبرة الشهداء بمسقط رأسي. كان أحد رفاقي يعمل آنذاك في القيادة العسكرية الإقليمية لتاي نينه . انطلقتُ بثقة، واثقًا من أنني سأُنجز المهمة.
تساءل رفيقي في السلاح وناقشني: "ليس لديك سوى اسم غامض لجدول ثا لا. هناك عدة أماكن تُسمى ثا لا في هذه المقاطعة. هل تعرف أي ثا لا؟ عند عبور جدول ضحل، ثم التعرض للقصف في منتصف الجدول، والطريق يسد اتجاه المسير، أعتقد أنه قد يكون جدول ثا لا في تان بيان."
هناك، أُنشئت بلدية اقتصادية جديدة. إذا أُزيلت شجرة الكابوك وقبر العم تونغ ودُمّرا، فسيكون من الصعب جدًا العثور عليهما. أنا مشغول بدراسة القرار لأسبوع آخر. كلما تأخر كان ذلك أفضل. يمكنك أن تأخذ سيارة "سيكس-سيفين" الخاصة بي وتذهب إلى هناك أولًا. سأتصل برجال المنطقة والبلدية الاقتصادية الجديدة للمساعدة.
قدتُ السيارة مباشرةً من بلدة تاي نينه إلى منطقة تان بين. وعندما وصلتُ إلى مفترق طرق دونغ بان، لم أتوقع أن سوقًا يعجّ بالناس يبيعون ويشترون قد تشكّل هنا. ومن هناك، كان هناك طريقٌ يتجه إلى المجمع الاقتصادي الجديد، ثم إلى ضفة نهر ثا لا. سعدتُ لأنني ربما وجدتُ المكان المناسب الذي توفي فيه عمي ذلك العام.
انتابني قلقٌ شديد، فبعد أربع سنوات فقط من السلام، أصبح طريق المواصلات الذي كان يمرّ تحت أشجار الغابة خاليًا من أي ظلال أشجار عتيقة. أمام عينيّ حقولٌ خضراء لا نهاية لها من قصب السكر والكسافا، واحدة تلو الأخرى. هل لا تزال آثار الماضي سليمة؟
لحسن الحظ، لا تزال شجرة الكابوك في وسط الغابة، التي لطالما حمّت قبر عمي الذي بُني على عجل، قائمة. غرّدت وأومأت إليّ بطبقات من اللهب المتألق الذي انعكس في سماء مارس الزرقاء الصافية. جذع غصنها، الذي كان يشير إلى هلال تلك الليلة، لا يزال يُظهر نفس حزن وقت الحداد.
كان المكان الذي مزقت فيه شظايا القنبلة جزءًا كبيرًا من لحاء الشجرة لا يزال يكشف عن ثقب أسود عميق ملطخ بالدخان. خمنت أن المنطقة الاقتصادية الجديدة بدأت من قاعدة هذه الشجرة. كانت العديد من المنازل المسقوفة بالقش والجدران الطينية متشابهة في الحجم والطراز، وواجهاتها تواجه الطريق الترابي الأحمر المستقيم.
في كل ساحة ترابية، كان هناك أطفال يتجولون مع الدجاج والبط. أوقفتُ دراجتي تحت ظل شجرة كابوك تُظلل نصف الطريق، ووقفتُ بتوتر أمام بوابة الخيزران المفتوحة، أُجهد عينيّ لأُلقي نظرة على شجرة الكابوك المُستقرة داخل سياج حديقة بعرض ثلاثة أمتار تقريبًا.
منزل صغير، واجهته مصنوعة من ألواح خشبية حديثة النشر، لا تزال تحتفظ بلون الخشب المحمر. كان باب المدخل مفتوحًا على مصراعيه، بلوحيه الخشبيين. كان يجلس على الأرض رجل عاري الصدر، أو بالأحرى، نصف رجل فقط. لاحظتُ مع مرور الوقت فخذين قصيرين أسودين يبرزان من ساقي سرواله القصير.
عُلِّقت لوحة خشبية كُتِبَ عليها بخطٍّ سريع: "تو دوآن يُصلِح الأقفال، ويُصَلِّح السيارات، ويُنفِّخ ويُكبس الإطارات" على أعلى العمود الذي كان يجلس فيه. سألتُ: "سيدي، هل يُمكنني الزيارة؟" أجاب بهدوء، لا لامبالٍ ولا حماس: "ما الأمر، هل تحتاج إلى إصلاح سيارتك؟" "لا، ولكن نعم."
أدخلتُ الدراجة إلى الفناء، ورفعتُ الحامل المركزي، وطلبتُ منه شدّ السلسلة. كانت مرتخية جدًا وظلّت تُصدر أصوات طقطقة. زحف صاحب المنزل إلى جانب الدراجة، واضعًا يديه على الكرسي الخشبي ومُلقيًا بجسمه بالكامل إلى الأمام. وبينما كان منشغلًا بشدّ البراغي، بدأتُ محادثةً: "منذ متى لم تتعرض لحادث؟" "أي نوع من الحوادث؟ أنا مُحارب قديم مُعاق".
في مارس ١٩٧٥، كنت لا أزال في المستشفى العسكري الجمهوري. بعد التحرير، استمر المستشفى العسكري الثوري في علاجي حتى شُفيت جراحي. في عام ١٩٧٦، تطوّعتُ أنا وزوجتي وطفليّ للقدوم إلى هنا لبناء قرية اقتصادية جديدة. عشنا حياةً هانئة حتى الآن.
سأل مرة أخرى: "أين أنتِ وأطفالكِ؟". "تعمل أمهم في تقشير قشور الكسافا لمصنع معالجة النشا. يذهب الطفلان إلى المدرسة صباحًا ويعملان مع والدتهما بعد الظهر." سأل مرة أخرى: "هل هناك نقص كبير؟". "إذا كنتِ تعرفين ما يكفي، فهذا يكفي. خضراوات من الحديقة. أرز من السوق. ثلاث وجبات كاملة يوميًا، ونوم هانئ."
أشرتُ إلى زاوية الحديقة أمام المنزل حيث كان العشب كثيفًا لدرجة أنه لم يكن من الممكن زراعة أي أشجار بسبب ظل شجرة الكابوك. سألتُ: "سمعتُ آنذاك، عندما كنا نُزيل الغابة لإنشاء منطقة اقتصادية جديدة، قطعنا جميع الأشجار الكبيرة والصغيرة، ولكن لماذا تُركت شجرة الكابوك هذه؟" "عندما جئتُ لاستلام المنزل، رأيتُ تلك الشجرة هناك. كنتُ أتساءل مثلك. سألتُ من سبقوني، وقالوا جميعًا: يبدو أن هناك نوعًا من الروحانية. كل من جاء لقطع هذه الشجرة استسلم بوجه شاحب.
ثم نقر قائد الفريق بلسانه: دعوها تزدهر كل موسم لتجميل المنظر. تنافس الجميع على المنزل والقطعة السكنية أمام البلدية. بعد بضعة أيام، طلبوا جميعًا الانتقال إلى منزل آخر. وعندما سُئلوا عن السبب، هزّوا رؤوسهم جميعًا في صمت. وصلت عائلتي آخرًا، وعاشوا هناك بسلام منذ ذلك الحين.
هناك أمر واحد، قل للجنود ألا يلوموني على نشر الخرافات. صحيح أنني طلبت من رسام قطع شجرة القطن تلك عدة مرات، لكنني لم أستطع تحمل ذلك. ففي كل عام، أحلم عشرات المرات بجندي شاب قادم من شجرة القطن في زاوية الحديقة إلى منزلي ويدعوني لشرب الخمر.
كانت كل حفلة شرب مزدحمة للغاية، سواءً من جيش التحرير أو جيش جمهورية فيتنام، حيث تعانق الجميع، ورقصوا، وغنوا موسيقى صفراء وحمراء. في صباح اليوم التالي، كانت رائحة الكحول لا تزال تفوح من أنفاسي. لكن الغريب أنني عندما كنت معه، كنت جنديًا ذا ساقين، سعيدًا وخاليًا من الهموم. كلما غاب عني لفترة طويلة، كنت أشعر بحزن شديد وغياب للذهن.
حينها فقط قلتُ الحقيقة: "ربما يكون ذلك الجندي عمي. هناك في العشب المتشابك، دفنّا عمي منذ أكثر من عشر سنوات. لا تزال هناك صخرة لاتريت على الأرض حيث وضعنا علامة عليها. شكرًا لكم على الحفاظ عليها سليمة حتى يتسنى لي إعادة عمي إلى مسقط رأسه." عند سماع ذلك، كاد تو دوان أن يسقط أرضًا، واتسعت عيناه، وانفتح فمه، وكرر: "إنه لينه حقًا، إنه لينه حقًا. لقد كنا معًا لفترة طويلة، لكننا لم نعرف كيف نشعل له البخور في يوم اكتمال القمر. يا للأسف!"
نظفتُ أنا والسيد دوآن العشب في زاوية الحديقة. برزت قمة صخرة اللاتريت حوالي عشرة سنتيمترات فوق الأرض. هذا يُثبت أن قبر العم تونغ لا يزال سليمًا منذ تلك الليلة وحتى الآن. أحرقتُ كل البخور ورتبتُ القرابين التي أحضرتها من مسقط رأسي لوضعها فوق كومة التراب. ركعتُ على الأرض، وانحنيتُ رأسي وشبكتُ يديَّ ثلاث مرات لأُقدم احترامي للعم تونغ، وانهمرت دموعي على قبره الذي نُزعت عنه الأشواك.
جلس بجانبي المحارب القديم ذو الإعاقة تو دوآن، وانحنى هو الآخر برأسه، والدموع تنهمر على وجهه، وقال بضع كلمات: "أطلب من روحك بكل احترام أن تسامحني على بقائي معك كل هذه المدة دون أن أقدم ولو عود بخور واحد". عزّيته قائلًا: "ليس ذنبي إن لم أكن أعلم. أرواح الموتى أرحم وأحكم منا نحن البشر، يا صديقي!"
كان البخور على قبر العم تونغ يشتعل بشدة. ساد ظهيرة مارس هدوء وسكينة، وتساقطت أزهار القطن الحمراء الزاهية بهدوء على الأرض. بدت أزهار القطن هذا العام نضرة على غير العادة، ولم تكن حزينة كفصول الزهور عندما كانت البلاد لا تزال غارقة في الدخان والنار.
في تي كيه
مصدر



![[صورة] رئيس الوزراء فام مينه تشينه يستقبل وفد شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SEMI)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/06/1762434628831_dsc-0219-jpg.webp)

![[صورة] اختتام المؤتمر الرابع عشر للجنة المركزية الثالثة عشر للحزب](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/06/1762404919012_a1-bnd-5975-5183-jpg.webp)



















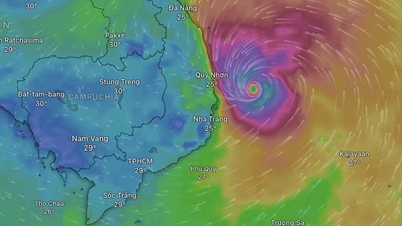
























































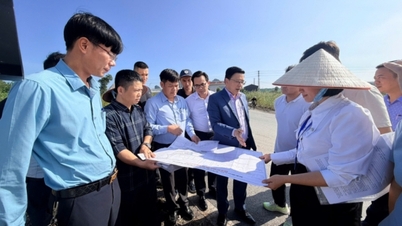






















تعليق (0)