 |
عندما وصلتُ إلى غرفة الطوارئ، رأيتُ عمتي جالسةً بجانبه بهدوء. انعكس ضوء المستشفى الأبيض البارد على وجهها، كاشفًا عن قلقها. كان مُتعبًا، لكن عندما رآني، حاول الابتسام، بدت عيناه الدافئتان كأنهما تُريدان تهدئة كل إرهاقي.
من بين الأطفال، كنتُ أكثر من أحب، ربما لأني أشبهه وكنتُ طالبةً مجتهدةً. نظر إليها بصوتٍ ضعيفٍ لكنه مليءٍ بالفخر: "طفلي سيلتحق بالصف العاشر العام المقبل. إنه يدرس بجدٍّ". ابتسمت، والتفتت لتسألني عن دراستي. عندما سمعت أنه ليس لديّ خططٌ للدراسة، فكرت مليًا وقالت: "لماذا لا تُجرّب امتحان القبول في المدارس المتخصصة الإقليمية؟ إنه صعبٌ جدًا، لكنني أؤمن بقدرتك على النجاح".
أشرقت عيناها وهي تتحدث، مما منحني الثقة. ثم رأت ركبتي تنزف. دون أن تنطق بكلمة، ذهبت لتحضر بعض القطن والكحول. وبينما كانت تضمّد جرحي، كانت يديها ناعمتين للغاية لدرجة أنني لم أشعر بأي ألم.
تدفقت ذكريات الطفولة في ذهني. أتذكر أنني كنت أتبع والدي إلى المدينة لبيع صلصة السمك. كانت تجلس في الأسفل، ممسكةً بقمع، تساعد والدها في صب صلصة السمك من علبة كبيرة في زجاجات صغيرة. كنت أقف بالقرب منها بفضول، عندما ضغطت العلبة عن غير قصد على ساقها. آلمني الأمر بشدة لدرجة أنني انتزعت ساقي بعيدًا، مما تسبب في تناثر صلصة السمك على قميصها. كان قميصها الذي كانت ترتديه للذهاب إلى العمل تفوح منه رائحة صلصة السمك القوية، لكنها ابتسمت بلطف، دون أن تُوبخني إطلاقًا. أحببتها منذ ذلك الحين.
ثم تذكرتُ عندما افتتحت منزلها الجديد. كان منزلًا كبيرًا من طابقين، ببلاط لامع ودرج حجري أصفر باهت. نظرتُ إلى كل شيء بشغف، مندهشًا. ناولتني زجاجة فانتا باردة وقالت: "اشربها، إنها لذيذة!". كانت تلك أول مرة أشرب فيها مشروبًا غازيًا. أسرني ذلك الطعم الغريب، الحلو، والبارد. بدت لي المدينة عالمًا جديدًا ساحرًا. منذ ذلك الحين، حلمتُ بالعيش فيها، مع أنني لم أفكر يومًا في مغادرة المنزل.
في نهاية الصف التاسع، مكثتُ في منزلها لأدرس لامتحان القبول في مدرسة متخصصة. كان امتحانًا صعبًا، وكانت نسبة التنافس فيه أعلى بكثير من امتحان القبول الجامعي. سجّلتني في ثلاث حصص إضافية، بجدولٍ حافلٍ من الصباح إلى المساء. أثقلتني الحصص الأولى. كان جميع الطلاب الآخرين في الصف متفوقين في الدراسة، لكنني كنتُ أجد صعوبةً في حل مسائل الرياضيات الصعبة.
في إحدى المرات، أحضرت لي مجموعة من أوراق الامتحانات القديمة. التقطتها وأنا أشعر بثقل في قلبي. أربكتني أسئلة الرياضيات المتخصصة، فلم أستطع فهمها، ناهيك عن حلها. لكن عندما انتقلت إلى أسئلة اللغة المتخصصة، أدركت فجأة أن لديّ فرصة. كانت أسئلة الأدب أنسب لي، وفتحت لي بابًا ضيقًا. كنت أكثر حماسًا، وأذاكر بجد. مع اقتراب يوم الامتحان، كنت أدرس مبكرًا ومتأخرًا. كانت عمتي آنذاك تسهر معي أيضًا، قلقة بشأن كل كوب حليب وكل وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل. كانت تشجعني وتؤمن بأنني سأنجح في الامتحان. كنت أدرس متأخرًا كل ليلة، وكانت تسهر، وتُعدّ لي الحليب، وتشجعني.
في يوم الامتحان، لم أكن موفقًا، وحصلت على نصف الدرجة فقط. غمرني الحزن، ظنًا مني أن الفرصة قد ضاعت. عدتُ إلى مدينتي. حينها، قررتُ الدراسة في مدينتي. قبيل موعد امتحان الالتحاق بالمدرسة الثانوية، اتصلت بي بصوتٍ يملؤه الفرح: "لقد نجحت! استعد للذهاب إلى المدرسة!" فوجئتُ وسألتها مجددًا: "هل نجحت حقًا؟ لقد كان أداؤي سيئًا للغاية في الامتحان؟" ابتسمت وقالت: "لقد نجحت بالفعل. يكفي من الدرجات، لكن النجاح يبقى نجاحًا!"
كنتُ آخر طالب ينجح في مقرر اللغات التخصصي ذلك العام. لو خسرتُ ربع نقطة، لكنتُ التحقتُ بمدرسة ثانوية تابعة للمنطقة. كانت المسافة الفاصلة بين المكانين، والتي تفصل بينهما 40 كيلومترًا، تساوي ربع النقطة بالنسبة لي.
غادرتُ مسقط رأسي، وذهبتُ إلى المدينة، وبدأتُ حياةً دراسيةً جديدة. في الأيام الأولى، أخذتني معلمتي إلى المدرسة على دراجة نارية. بعد يومين، اشترت لي دراجةً. تجولتُ بالدراجة في الشوارع المزدحمة، مفعمًا بالحماس. جعلتني المدرسة المتخصصة الكبيرة، بأشجارها الخضراء الظليلة وفصولها الدراسية الفسيحة، أقول لنفسي: "عليّ أن أبذل قصارى جهدي!". مع ذلك، لم تكن السنوات الثلاث في المدرسة المتخصصة سهلة.
اخترتُ اجتياز امتحان القبول الجامعي في العلوم الطبيعية، وهو خيارٌ مختلفٌ عن تخصص دراسات اللغات. فالدراسة في فصلٍ متخصصٍ تعني أنه بالإضافة إلى الدراسة الصباحية، كان عليّ حضور دروسٍ إضافيةٍ في المدرسة خمس مراتٍ أسبوعيًا بعد الظهر، منها ثلاث حصصٍ في اللغات الأجنبية. لذلك، لم يكن لديّ سوى ساعتين تقريبًا بعد الظهر والمساء لدراسة مواد إضافية في العلوم الطبيعية. ومع ضيق الوقت، كانت الدراسة الذاتية في المساء هي وقت دراستي الرئيسي.
خلال سنوات دراستي الثانوية، كنت أدرس حتى الواحدة أو الثانية صباحًا. في الصباح، عندما كنت أذهب إلى المدرسة، كنت دائمًا أعاني من قلة النوم وحمى خفيفة بسبب سهري لوقت متأخر. في العلية، في الليالي الطويلة، تحت مصباح المكتب، كنت أدرس بمفردي، وأعلق كلمة "سوف" على الحائط، كتذكير لنفسي بألا أستسلم. كانت دائمًا هناك، قلقة في صمت. في أحد الأيام، جاءت إلى غرفتي ورأتني لا أزال منغمسة في كتبي: "ادرس ببطء، اعتنِ بصحتك. كيف يمكنك مواصلة دراستك وأنت مريض؟"
يوم إعلان نتائج الجامعة، أتذكر تلك اللحظة بوضوح. آنذاك، لم تكن هناك هواتف محمولة ولا إنترنت للتحقق من النتائج. لم يكن بالإمكان إجراء أي شيء إلا عبر لوحة الهاتف الأرضي. في عصر ذلك اليوم، وبينما كانت تستعد للذهاب إلى العمل، جاءت صديقة لها كانت قد أدّت الامتحان معها لتخبرها بظهور النتائج. رفعت سماعة الهاتف الأرضي، واتصلت بالرقم، ثم اتصلت باللوحة. رنّت الأرقام الباردة على الطرف الآخر: "رياضيات ١٠، فيزياء ٩.٥، كيمياء ١٠". ما إن انتهت من حديثها، حتى وقفتُ ساكنًا، كأنني لا أصدق أذنيّ. التفتُّ لأنظر إليها، ولم أستطع كبح جماح مشاعري. عانقتني، ودموع الفرح في عينيها، وواسيتني قائلة: "لقد نجحت، لقد نجحت يا عزيزتي!". شعرتُ بالاختناق.
إنها ليست فقط القريبة الوحيدة التي شجعتني في كل محنة، بل هي أيضًا أحب شخص إلى قلبي. نظرتُ في عينيها، فرأيتُ فخرَ وفرحَ أمٍّ وخالةٍ رافقتني في كل خطوة. ربما هي أسعد مني، لأنها تحملت معي كل هذه المشقة والمتاعب حتى وصلتُ إلى هذا اليوم.
مرّ الوقت، التحقتُ بالجامعة، ثم تخرجتُ ودخلتُ العالم. شغلتني المشاريع والأعمال، لكنني تذكرتُ دائمًا ما علّمني إياه أستاذي: "تذكر، عند القيام بأي شيء، عليك أن تبذل قصارى جهدك، وأن تفعله بقلبٍ نقيّ. لاحقًا، سواء نجحتَ أم فشلت، فلا ندم على شيء، لأنك على الأقل بذلتَ قصارى جهدك". رافقني هذا التعليم طوال أشهر السفر والعمل والسعي لتحقيق أحلامي.
مؤخرًا، بينما كنت أعمل على مشروع بعيد في الشمال الشرقي، اتصلت بي أمي وقالت: "عمتي مريضة جدًا. عودي فورًا". شعرتُ بحزن شديد. حزمتُ أغراضي بسرعة، ثم استقلتُ الحافلة الليلية واتجهتُ مباشرةً إلى المدينة.
طوال رحلة العودة، كنتُ مستيقظًا في السيارة، عاجزًا عن النوم. تذكرتُ عمتي وهي ترعاه على سرير المستشفى. تذكرتُ ما قالته عمتي بعد وفاته. كانت حزينة وتنهدت وقالت لي: "الآن وقد رحل، ربما لم يعد لديّ سبب للعودة إلى مسقط رأسي". قبل ذلك، كانت تعود لزيارته كل أسبوعين. كانت تذهب إلى السوق وتطبخ له حساء السمك الحامض، طبقه المفضل. كانت تجلس وتراقبه وهو يأكل شيئًا فشيئًا. ثم انتابني الخوف، خشيت أن تتبعه عمتي إلى السحاب الأبيض كما فعلت من قبل.
وصلت السيارة إلى المدينة عندما بدأت السماء تشرق. دخلتُ منزلها وتوجهتُ بهدوء إلى غرفتها. بعد غياب طويل، أصبحت نحيفة للغاية. استلقت على السرير وفتحت عينيها قليلاً عندما سمعت خطواتي تقترب. أمسكت بيدها النحيلة دون أن أنطق بكلمة. تبادلنا النظرات، وعيناي مشوشتان. رفعتُ يدها وقبلتها برفق. همست: "لقد... عدتَ... اجلس... هنا... معي".
بقيتُ معها الأسبوعين التاليين حتى يوم رحيلها. كان ذلك اليوم باردًا وممطرًا، كنهاية فيلم أبيض وأسود، فيلم الحياة، صورة عمتي تتلاشى تدريجيًا وتختفي.
بكيت وهمست "آنسة!"
[إعلان 2]
المصدر: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/anh-sang-lang-tham-150127.html









































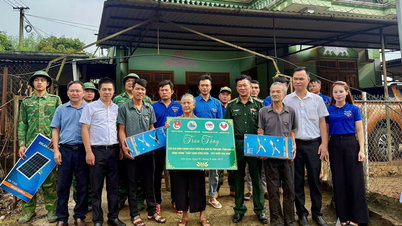
























































تعليق (0)