لا أتذكر محتوى الرسالة كاملاً، لكن خطها المعوجّ والموحّل كان يحمل دائمًا عبارات مثل: "أرسل بعض الأعمام والعمات في سايغون هدايا لأطفالهم، بما في ذلك حلوى جوز الهند والرامبوتان". كل شهر، كانت الرسالة المرسلة إلى والدي تذكر الهدايا التي تلقاها، وكيف تحول من عامل بناء إلى ماهر. كان يتفاخر بأنه لم يعد مضطرًا لحمل الأسمنت أو الملاط أو خلطه، بل أصبح قادرًا على البناء.

لمحة عن سايجون الأب من خلال عيون ابنته
في كل مرة كان يعود فيها والدي إلى مسقط رأسه، كان يحضر معه هدايا كثيرة، كالحلوى والرامبوتان والملابس الجديدة. في سنوات كان يحضر معه طقمًا جديدًا من أواني الخزف. كان يحفظها بعناية في الخزانة كقطعة ثمينة، وينصح أمي ألا تخرجها إلا في ذكرى وفاتها. كان هناك أيضًا تلفاز قديم بالأبيض والأسود وبعض عبوات حلوى جوز الهند، كنا نضحك كلما أكلتها أنا وأخواتي ونقول: " حلوى جوز الهند قاسية جدًا يا أبي، إنها تلتصق بأسناننا كثيرًا!". كان والدي يردد أنها هدية من بعض أعمامي وخالاتي في سايغون. لم أكن أعرف من هم، ولا أين يسكنون، ولم ألتقِ بهم قط. لكن في نظري، كان "الأعمام والخالات في سايغون" في غاية اللطف!
عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، زرت سايغون لأول مرة. أوصلني والدي من محطة الحافلات إلى دار الضيافة التي كان يسكنها - على دراجة نارية نصفها فقط من غطاءها الأمامي مضاء، وأضواؤها الأمامية تتأرجح كما لو كانت تطير في الريح. جلست في مؤخرة الدراجة النارية مبتسمًا، وعيناي تلمعان كلما اكتشفت شيئًا مثيرًا للاهتمام. بين الحين والآخر، كان والدي يربت على يدي ويقول: "ها هو السوبر ماركت يا بني!"، "ها هو الحديقة يا بني!"
لم أرَ مكانًا بمثل هذه الأضواء، أو ربما لم تطأ قدماي الصغيرتان أرضه طوال حياتي. حتى مدينتي ليست بهذا السطوع. كنت أكره الأضواء الوامضة لأنها كانت تُبهرني. لكن في اللحظة التي جلست فيها على الدراجة النارية، ووالدي يقودها في الشوارع المزدحمة، أدركتُ فجأةً أن أضواء سايغون دافئةٌ للغاية. هدّأت الأضواء كتفي والدي النحيلين، وهدأت قلب ذلك المتجول الذي كان يسعى جاهدًا لتحقيق حلمٍ صغير لي!

تجربة مع حافلة مائية في سايغون
في رحلتي إلى سايغون، لم أزر دام سين كما حلمت، بل قضيت معظم الوقت المتبقي في موقع بناء والدي. جلست في كوخ بسيط، على ألواح خشبية، وفرش لي أبي حصيرةً لأعمل عليها. في المساء، كان أبي يأخذني إلى زقاق، إلى صف من بيوت الضيافة المتهالكة المعرضة للشمس والمطر. تحدث أبي مع امرأة بصوت غريب لم أفهمه. ثم اصطحبني أبي لتناول "دزيت لا" الساخن. أكلت وضحكت. هنا، لا يقولون "عن" بل "عن"، ولا يقولون "ماذا حدث" كما في مسقط رأسي. كانت هناك أشياء غريبة أخرى كثيرة لا أتذكرها.
الآن وقد كبرت، أتيحت لي فرصة زيارة سايغون مرة أخرى. هذه الرحلة مختلفة تمامًا عن المرة الأولى. أرى سايغون صاخبة ومشرقة، لكنها أيضًا بائسة، بحياة من هم بعيدون عن ديارهم. وخاصةً عندما أنظر إلى مواقع البناء، ينفطر قلبي حزنًا في كل مرة. هل كان والدي موجودًا هناك قبل نحو عشرين عامًا - يضع كل لبنة، ويحمل كل دلو من الملاط؟
قال والدي إن سايغون كبيرة جدًا. لكنني أرى سايغون صغيرة كظهر والدي.
قال والدي إن أهل سايغون كرماء جدًا، لكنني أعتقد أن هذا لا يزال ينقصهم. فهم أيضًا ودودون ومحبوبون.
مرّ أكثر من خمسة عشر عامًا، ولم يعد والدي إلى سايغون مجددًا. أبقته الشيخوخة والعلاقات في وطنه. ومع ذلك، لا يزال يتابع أخبار تلك البلاد البعيدة. أتذكر أمسيات كان والدي يجلس فيها على الشرفة، يرتشف النبيذ ويروي لنا قصصًا من الجنوب. كان هناك وقت ظننت فيه أن سايغون هي مسقط رأس والدي. لم يُخبرني والدي قط بمدى روعة سايغون، ولكن من عينيه وابتسامته، رأيت كم كانت سايغون جميلة.
أبي يُحب سايغون بطريقة مختلفة عني. من قضى قرابة عقد في سايغون يختلف عن فتاة بريئة لا تفهم شيئًا. من عاش فيها نصف عمره تقريبًا يختلف عن فتاة جاءت فقط لتحقيق حلمها بالذهاب إلى دام سين.
أحب والدي سايغون كما لو كانت موطنه الثاني. أرضه الطيبة وشعبه الكريم آنذاك وفرت له مكانًا للنوم والعمل. أعطوه حقيبة ظهر جديدة بدلًا من القديمة، وزيًا رسميًا جديدًا بدلًا من قميصه البالي.
أما أنا، فأحب سايغون لأن تلك الأرض تسامحت مع والدي، واحتضنته في قلبها. سايغون غذّت أحلامنا - أطفالنا الذين يبعدون آلاف الكيلومترات.
كانت سايغون تُهدي والدي أصدقاء، وتُهدينا هدايا. مع أنني لم ألتقِ بهم قط، ولم أعرفهم قط، إلا أنني كلما سمعت والدي يذكر كلمتي "الأعمام والعمات في سايغون"، كنت أشعر بحبٍّ كبير لهم.
في كثير من الأحيان أفكر، لو لم يكن سايجون والدي، لم نكن لنكون حيث نحن الآن.
سايجون بلدي، سايجون بلدي!

[إعلان 2]
رابط المصدر




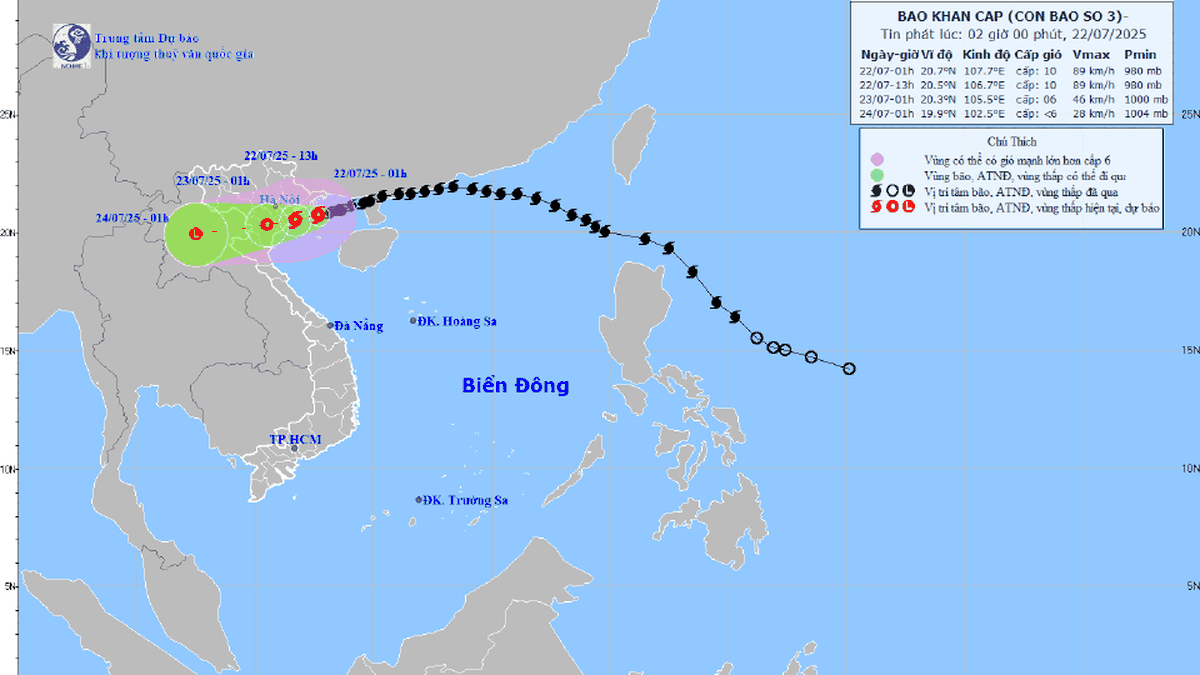























![[صورة] رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان يزور الأم البطلة الفيتنامية تا ثي تران](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)



























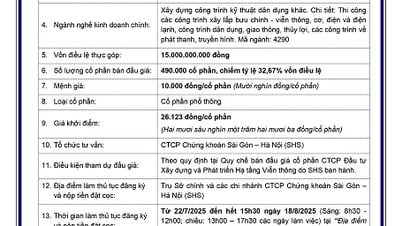








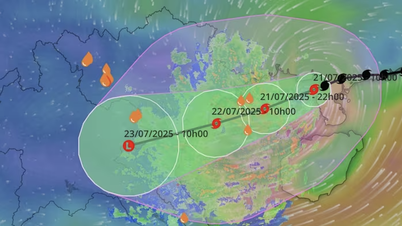











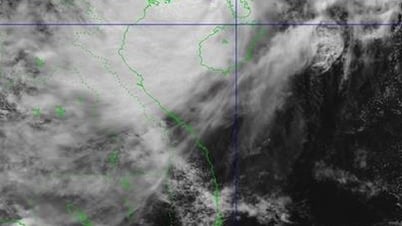























تعليق (0)