١. فقدت معلمتي والدتها في يوم بارد من نهاية العام. الفتاة التي كانت تغمرها السعادة أصبحت فجأة يتيمة. أعلم أن ألم فقدان والدتها لم يهدأ فيها يومًا على مر السنين. تروي قصص والدتها دائمًا بصوت رقيق كدخان الصباح، خفيف ومرتجف، وكأنها تريد كبت ألم لا ينتهي يكاد ينفجر في عينيها. كثيرًا ما تتحدث عن والدتها، صوتها مرتجف ودافئ في آن واحد. لم أرها تبكي قط، ولكن في كل مرة تذكر فيها والدتها، تمتلئ عيناها بالدموع، وتبتعد نظرتها كما لو كانت تسترجع ذكريات دخان المطبخ ووجه والدتها العزيز. صوتها بطيء ومتقطع، وكأنها تخشى أن تنطق بكلمة أخرى، فتسيل دموعها.
قالت، في الصباحات القديمة، تعود ذكريات أمها دائمًا بوضوح كما لو كانت بالأمس: "في ذلك الوقت، صوت الرياح وهي تهب المطر خارج النافذة، ورائحة دخان المطبخ الدافئة المنبعثة من المطبخ الخلفي. صوت خطوات الأم المتسارعة، ثم صوت دفع الدلاء والأواني. قطرات الماء من السقف المبلط القديم تتساقط على الدلاء والأواني، تينغ تينغ، تينغ تينغ، تينغ تينغ. أنين الخنازير تطلب الطعام، صوت صرير باب الحظيرة وهو يُفتح بينما كانت الدجاجات تُصدر حفيفًا على أغصان الأشجار... رائحة عصيدة الكسافا الغنية ترتفع مع رائحة أوراق التنبول القوية النفاذة، تشاو أوي لا كون...".
 |
| الرسم التوضيحي: HH |
ثم اختنق صوتها في ذلك الصباح، كانت تنوي النوم لفترة أطول قليلاً، لكنها أدركت فجأة أنه لم يعد هناك رائحة دخان من المطبخ، ولا وقع أقدام. لم يكن هناك سوى صوت المطر كأنه يتردد صداه في ذكرياتها، وفراغ مفجع. لقد رحلت أمها منذ زمن، لكن شوقها لا يزال يملأ قلبها. في كل مرة تمطر فيها، كانت تنظر من النافذة شارد الذهن: "أتساءل، هناك... غدًا صباحًا، هل أشعلت أمي الموقد؟". "هناك"، كما قالت، بدا صوتها خفيفًا جدًا ولكنه حزين للغاية. كانت مسافة لا يمكن بلوغها أبدًا، لكن الشوق كان كثيفًا جدًا.
٢. في طفولتي، لم يكن الفجر يبدأ بصياح الديك، بل بطقطقة الحطب في الموقد المشتعل. في تلك الصباحات الباكرة، حين كان الظلام لا يزال يلف المطبخ الصغير، كانت أمي تستيقظ وتشعل الموقد بنشاط. بدا أن أصوات الضوء توقظ هدوء الصباح الباكر. ألقى الضوء المتذبذب في الزاوية الرمادية من المطبخ ضوءًا أصفر خافتًا على الجدار القديم كأنفاس. انحنت أمي فوق الموقد، ويداها المتشققتان تشعلان الحطب، وتردد صوت الطقطقة في ضباب الصباح البارد. فجأةً، دفأ المطبخ الصغير البارد بأكمله بالدخان الرمادي.
كانت والدتي تبيع المعكرونة في سوق القرية كل صباح. ربّاني هذا الكشك أنا وأخواتي، وساعد العائلة بأكملها على تجاوز مواسم العجاف. من المطبخ الممتلئ برائحة الدخان الرمادي، جابت أكشاك المعكرونة الخاصة بوالدتي الشوارع، وعبرت كل زاوية في السوق، لكنها أيضًا جعلت يديها متصلبتين وظهرها منحنيًا على مر السنين. لذلك، لم تقتصر رائحة دخان الخشب في ذلك اليوم على ملابسها وشعرها فحسب، بل التصقت أيضًا بذكريات طفولتي. كانت تلك سنوات الكفاح والمشقة، وصباحات باردة تخترق الجلد، ومع ذلك كانت والدتي تستيقظ وتحمل قدر المعكرونة إلى السوق. كان طريق القرية لا يزال غارقًا في هواء الليل، والأغصان والأوراق ذابلة من البرد القارس. كانت أعمدة الكتف ثقيلة. انبعثت الحرارة، ممزوجة برائحة دخان الخشب لتخلق رائحة مألوفة مفجعة. مرت والدتي، ولا يزال دخان المطبخ عالقًا بقميصها الباهت.
لم يكن سوق الريف مزدحمًا آنذاك، لم يكن فيه سوى قلة من الناس. نصبت أمي كشكها على الشرفة الصغيرة، ويداها تغرفان المعكرونة بسرعة، وعيناها تدمعان من الدخان، والريح الباردة، أو من هموم لم تتحدث عنها قط. بالنسبة لي، كان طبق المعكرونة الذي طهته أمي أشهى شيء في العالم، لأنه كان مليئًا بحلاوة الحب، والعرق، وليالي القلق الطويلة، وبالطبع، ممزوجًا برائحة دخان المطبخ.
٣. كبرنا وتركنا المطبخ الصغير. لم تعد هموم كسب الرزق تُرهقنا كما كانت في الماضي، لكن أمي ظلت متمسكة بعادة الاستيقاظ كل صباح لإشعال الموقد. أحيانًا كان ذلك مجرد وسيلة لها لنسيان وحدة الشيخوخة. كان المطبخ صغيرًا، لكنه مُضاء بنور هادئ.
في المدينة، أحيانًا، في أحلامي، أرى نفسي جالسًا أمام كشك المعكرونة القديم، والدخان يتصاعد، وأمي تبتسم ابتسامة خفيفة، وعيناها تلمعان في الدخان الرمادي. أستيقظ، وقلبي يخفق بشدة. أتساءل إن كانت أمي قد استيقظت في هذا الوقت، في الوطن، لإشعال الموقد، وهي لا تزال منحنية على قدر المرق الساخن في الصباح الباكر؟ أعمل في مكان بعيد، وفي كل مرة أعود فيها إلى مسقط رأسي، أول ما أفعله هو دخول المطبخ، والجلوس بهدوء، والنظر إلى الرماد، ويدي تداعب الحجر الذي كان يحمل القدر من الماضي. تتدفق ذكريات كثيرة، عالقة كدخان خفيف.
أخبرني مُعلّمي أنّه مع مرور الوقت، يتلاشى دخان المطبخ القديم تدريجيًا خلف الجدران الخرسانية. نحن منشغلون بالعمل، نستيقظ على صوت الهاتف، نطهو على موقد كهربائي لامع، لا مزيد من الدخان يُحرق أعيننا، ولا مزيد من رائحة القش الرطب على ملابسنا. لكن وسط هذا الكمّ الهائل من الدخان، نشعر بنقصٍ ما، دافئ وقديم. هناك أيام نسير فيها في الشوارع الصاخبة، فنتوقف فجأةً أمام الدخان المتصاعد من مطعم على جانب الطريق، والدموع تملأ أعيننا. لأنّنا في ذلك الدخان، يبدو أننا نتعرّف على جسد أمّنا الصغير، بكتفيها المنحنيين، ويديها تتحركان بسرعة بجانب الموقد الرمادي المُدخن.
يتضح أنه في حيوات لا تُحصى، ستمرّ منعطفات لا تُحصى، واختلافات لا تُحصى، لكننا ما زلنا نتشارك ذكريات الفقر في الماضي. تلك الذكريات كخيوط دخان رقيقة، لا تزال قوية بما يكفي للتمسك بالأشياء الجميلة وسط صخب الحياة اليومية. ثم، حتى مع مرور الوقت، لا يزال الناس لا ينسون أول نار في حياتهم - نار أمهاتهم. وكل ذكريات أمهاتهم قد تبدأ من صباح باكر، من موقد، من خيط دخان في الضباب. طوال حياتنا، أينما ذهبنا، ما زال شوقٌ يطاردنا: "هذا الصباح، هل أشعلت أمي الموقد بعد..."
ديو هونغ
(*) مقتبس من قصيدة "نار المطبخ" (بانج فييت).
المصدر: https://baoquangtri.vn/van-hoa/tap-but/202511/som-mai-nay-me-nhom-bep-len-chua-c8c6b16/



![[صورة] الأمين العام تو لام يستقبل السفير السنغافوري جايا راتنام](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762171461424_a1-bnd-5309-9100-jpg.webp)
![[صورة] رئيس الوزراء فام مينه تشينه يستقبل رئيس جمعية الصداقة اليابانية الفيتنامية في منطقة كانساي](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762176259003_ndo_br_dsc-9224-jpg.webp)

![[صورة] لام دونج: صورة مقربة لبحيرة غير قانونية ذات جدار مكسور](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762166057849_a5018a8dcbd5478b1ec4-jpg.webp)
![[صورة] معرض الخريف 2025 وأرقام قياسية مبهرة](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762180761230_ndo_br_tk-hcmt-15-jpg.webp)













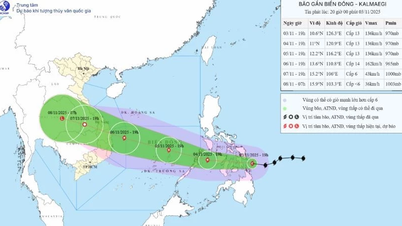




















































































تعليق (0)