نحن الآن في نهاية شهر نوفمبر، أي بعد قرابة شهر من عيد الهالوين (31 أكتوبر)، ولكن في كل مرة نلتقي فيها لتناول القهوة، ترفض فورًا اختيار إم بي. لأنها وابنتها ذات الخمس سنوات لا تزالان تطاردهما الصور الدموية المرعبة التي زينها صاحب المنزل قبل المهرجان. قالت إن ابنتها استيقظت وبكت لعدة ليالٍ متتالية. والآن مع حلول الليل، ورغم أن الأضواء مضاءة في جميع أنحاء المنزل، فإن ابنتها تتبعها في كل خطوة تخطوها.
يُعرف عيد الهالوين بأنه يومٌ لإحياء ذكرى الموتى واستقبالهم في ديارهم. رمز العيد هو القرع المنحوت عليه وجوه. ومع ذلك، في بلدنا، تحوّل هذا المهرجان بسبب نقص وعي البعض. يعتقدون أن الهالوين يجب أن يكون مُزيّنًا بأزياء رعب، يُخيفون بعضهم البعض لإضحاك الآخرين، ليكون روح المهرجان الحقيقية.
إن روح "التبادل الثقافي" و"التجربة" و" الاكتشاف " غير موجودة في أي مكان، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: هذه الصورة المرعبة سوف تطارد نفسية الأطفال غير الناضجة وهي غير مناسبة لثقافة وعادات الشعب الفيتنامي.

وفقًا لإحصاءات وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، يوجد حاليًا حوالي عشرة مهرجانات مستوردة من الخارج، وخاصة من الدول الغربية. وقد برزت هذه المهرجانات بشكل طبيعي عندما انفتحت الحدود بين دول العالم، مما ساهم في إثراء الحياة الثقافية للشعب الفيتنامي. من بين هذه المهرجانات، هناك ثلاثة مهرجانات تلقى إقبالًا كبيرًا من الشباب، باعتبارها جزءًا من حياتهم الروحية في نهاية العام، وهي: الهالوين، ونويل (عيد الميلاد)، وفالنتاين (عيد الحب). هذه الديناميكية والإبداع هما ما يُسهمان في إثراء الهوية الثقافية الوطنية، وخلق مزيج متناغم بين القديم والجديد، والكلاسيكي والحديث، والتقليدي والمبتكر. لو استجابت الأنشطة لهذه المهرجانات بمعناها الإنساني الأصيل، لما كان هناك ما يُقال، بل إنها "تتحول" وتندمج في المهرجانات بأسلوب "مختلف"، ليتواكب بشكل رئيسي مع التوجهات العصرية، مُبرزةً "روعتها" ورقيها.

٢. في مواجهة التدفق الهائل للثقافات الأجنبية، انتهزت شريحة من الشباب الفيتنامي الفرصة لتطوير ثقافتهم الوطنية الغنية والجميلة أصلاً، لتصبح أكثر تحضراً وتقدماً. يتمثل ذلك في الترويج لثقافة الوقوف في طوابير أمام مقاهي الشاي والقهوة بالحليب التي تقدم على المنضدة. قد يبدو الأمر غريباً ومزعجاً في البداية، لكنه بعد فترة يصبح مألوفاً ويُظهر الجميع إعجابهم. فهناك، يقف أول الوافدين في المقدمة، وآخر الوافدين في الخلف. لا يوجد أي تدافع أو دفع على الإطلاق.
شارك هذه القصة مع كبار السن. أعربوا عن رضاهم، وأضافوا أنه في بلدنا، خلال فترة الدعم، ترسخت ثقافة الوقوف في الطوابير، وأصبحت قاعدةً يلتزم بها المجتمع بأكمله. كان على من يرغب في شراء أي شيء من الضروريات والضروريات أن يقف في طوابير. حتى أنهم كانوا مستعدين للوقوف في طوابير من الثانية أو الثالثة صباحًا انتظارًا لدورهم في المتاجر الحكومية. في ذلك الوقت، كان المجتمع لا يزال يواجه صعوباتٍ ونقصًا في السلع، لكن ثقافة الوقوف في الطوابير كانت تُحترم، وكان الناس يلتزمون بها بجدية.
اليوم، يُدرّس الوقوف في الطوابير من الروضة إلى التعليم العالي. إلا أن الكثيرين ينسون ثقافة الوقوف في الطوابير عندما يكبرون، مما يؤدي إلى مشاهد فوضوية يمكن لأي شخص رؤيتها في محلات التسوق ومحطات الحافلات وغيرها. حتى أن البعض يتزاحم ويتزاحم على الأرصفة والأرصفة المخصصة للمشاة.
الثقافة ليست ثابتة، بل قابلة للتغيير والتطور والتكامل بما يتناسب مع الواقع. ومثل فعل الوقوف في الطوابير، وإن كان صغيرًا، إلا أنه يعود بفوائد جمة على الأفراد والمجتمع. فعندما يلتزم الجميع بالنظام، يُسهّل ذلك الأمور ويُسرّعها ويُسهّلها على جميع المشاركين. أما إذا نُسيَ الوقوف في الطوابير أو رُفض بسلوكٍ غير مُريح، فسيُصبح كل شيء فوضويًا، وسيتباطأ كل شيء، أو يسوء.
مصدر


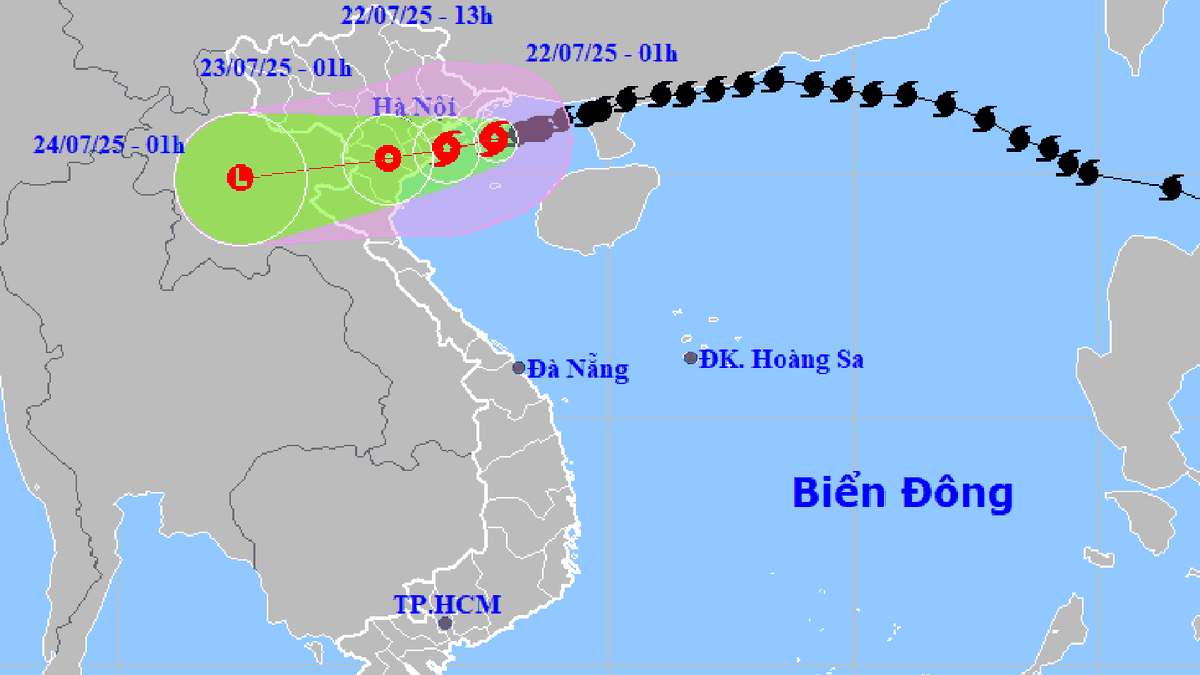








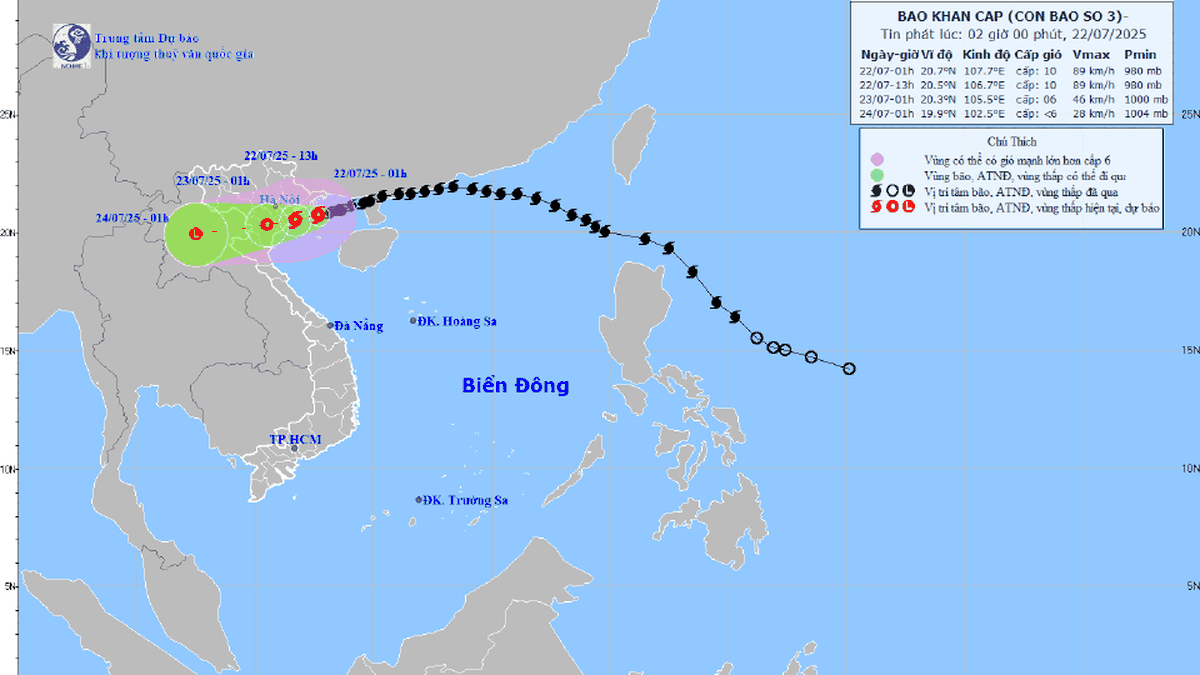
















![[صورة] رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان يزور الأم البطلة الفيتنامية تا ثي تران](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)



























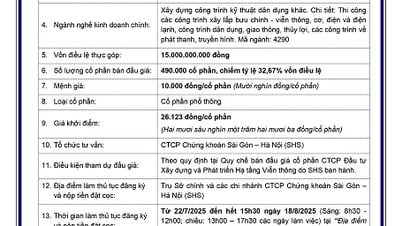








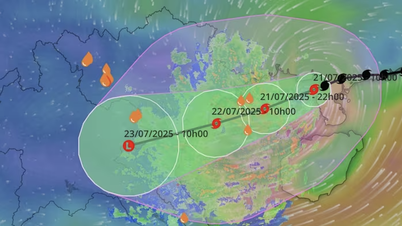











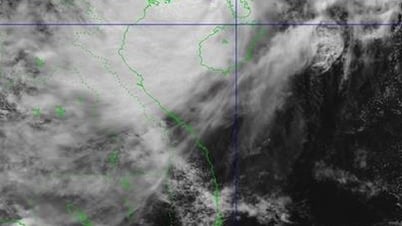























تعليق (0)