في ذلك العام، قبل أكثر من نصف قرن، بلغ جدي الخمسين من عمره، وهو ما كان يُعتبر شيخًا آنذاك. لكنه كان لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وكثيرًا ما كان يقول لنا بثقة: "لا يزال أمامي ثلاثون عامًا أخرى، وعندما يُرزق عمكما وعمتكما هوان بأطفال، سأدعو الله أن يعيدني إلى خدمتكم".
كان عمي هوان يدرس في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة المنطقة، وهو ما يعادل الصف السادس حاليًا. مع ذلك، لم يكن في القرية سوى خمسة أشخاص، بينهم أنثى واحدة فقط، وهي الآنسة شوان، الابنة الصغرى للسيد كينه، الطبيب في القرية السفلى. كانت الآنسة شوان من أجمل فتيات القرية، وكانت أيضًا من عائلة مثقفة، لذا كان الكثير من رجال ونساء القرية يتطلعون إليها كزوج لأبنائهم. لكن يبدو أنها اختارت عمي هوان عشيقًا لها. هكذا رأيت الأمر في صغري.
كانت مدرسة المنطقة تبعد عن المنزل قرابة عشرة كيلومترات. كل صباح، كان الأعمام والعمات ينتظرون بعضهم البعض للمشي معًا بينما لا يزال طريق القرية مظلمًا. تحت أقدامهم، لم يروا سوى التربة البيضاء المتعرجة بين صفين من الخيزران بأغصانه وأوراقه الكثيفة. وفوق رؤوسهم، كانت براعم الخيزران المنحنية تتدلى على أكتاف بعضها البعض، تتمايل بحب. في السماء، لا تزال نجوم شاحبة لا تُحصى تظهر، كما لو كانت نائمة. ارتفعت السماء لتغسل وجهها عند سفح النهر، لكنها لم تختفِ بعد في السماء، سامحةً للغيوم الداكنة بالتوهج بلون وردي. بدا أن النجوم كانت أيضًا فضولية، فترددت عمدًا لتنظر إلى الزوجين اللذين غمرتهما رائحة الحقول والريح، شاعرة برائحة الحب. وبدا أن جدي كان سعيدًا بشكل واضح عندما خمن أنهما مغرمان ببعضهما البعض. لذا، كل صباح، عندما كان يخرج لفتح الباب لعمي، كان يخطو بحماس عبر البوابتين بعد بضع نداءات صغيرة واضحة من السيدة شوان. كان يقف ويراقب الظلين وهما يختفيان تدريجيًا في الضباب البارد قبل أن يعود إلى المنزل ويجلس على الأريكة التي كانت هناك منذ أن كان جدي معلمًا. ثم كان يسحب غليونًا من التبغ يبدو وكأنه مفرقعة نارية، يغطي فمه وينفث ببطء سحابة رقيقة من الدخان الحالم. ربما كانت تلك أمتع لحظة في اليوم بالنسبة له. بعد سنوات عديدة، ما زلت أتذكر بوضوح في ذكريات طفولتي عينيه المتلألئتين من الضحك وعينيه نصف المغمضتين وهو يراقب الدخان الأبيض اللبني ينبعث من الباب كل صباح هادئ في الماضي.
عندما كنت في السادسة من عمري بالضبط، وكنتُ حينها في سنّ الالتحاق بصفّ روضة الأطفال في القرية، كان ذلك أيضًا حدثًا بارزًا لا يُنسى لعائلتي. كان ذلك خلال مراسم تأبين جدّي الأكبر، حيث أعلن جدّي لجميع الأقارب أنه سيُخصّص نصف الحديقة لزراعة أشجار الزان، بحيث يكون هناك خلال عشر سنوات ما يكفي من الخشب لبناء منزل لزواج عمّي. ثم بدأ في فعل ذلك. كان نصف الحديقة المجاور لطريق القرية مُورقًا بصفوف من أشجار الزان التي كانت تُعطي عائلتي ثمارًا كثيرة بحجم أوعية الأرز كل عام. ومع ذلك، وبعد بضع جلسات من العمل الشاق، أزال جدّي جميعها. وبدلاً من ذلك، زرع صفّين من أشجار الزان، مع أكثر من ثلاثين شجرة في صف واحد على طول حافة طريق القرية. ندمت جدتي على أشجار الزان التي كانت لا تزال تسمح لها بالذهاب إلى الحقول عندما تنضج الثمار، وظلّت تُلحّ على جدّي بسبب طباعه السيئة. عندما كنتُ في الصف الثالث، كان صفّ أشجار الزان يبلغ من العمر ثلاث سنوات أيضًا. كانت جذوع كل شجرة مستقيمة ومتساوية الحجم كالمحراث، وطبقات الأوراق متكدسة لامعة بلون أخضر داكن. كانت العديد من أشجار الزان قد وصلت إلى السطح، أول مكان تستقبله أشعة شمس الفجر، بدت كمظلات ذهبية لامعة تغطي رؤوس الأميرات في القصص الخيالية. في فترة ما بعد الظهيرة الهادئة، كان جدي يستمتع غالبًا بالمشي وحيدًا بين صفوف أشجار الزان، متوقفًا من حين لآخر ليستخدم يديه الخشنتين كمزارع عجوز لمداعبة جذوع الأشجار المليئة بالنسغ بحب. في ذلك الوقت، امتلأ قلبه بالرضا، وهو يفكر في اليوم الذي سيقطع فيه بنفسه حديقة الزان بأكملها وينقعها بعناية ليبدأ بناء منزل لعمي هوان وزوجته. في إحدى المرات، في حماسه، أشار إلى كل شجرة وأخبرني بوضوح أي الأشجار ستُستخدم كأعمدة، وأيها ستُستخدم كعوارض، والأشجار المتبقية ستُستخدم كعوارض. سيكون منزلًا من خمس غرف، مصنوعًا بالكامل من أجمل أنواع خشب الزان الوردي اللامع في القرية. كانت هذه هي الجملة التي رددها عليّ مرارًا وتكرارًا، تأكيدًا على شغفه الذي دام طوال حياته.
كان ذلك في الربيع والصيف عندما كانت قريتي هادئة مؤقتًا، ولم تكن الحرب قد انتشرت بعد، لذلك كان بإمكان عائلتي قضاء أيام سعيدة من لم الشمل مؤقتًا. نمت حديقة الزان بشكل واضح يومًا بعد يوم. في حوالي نهاية فبراير إلى بداية مارس من كل عام، كانت أغصان الزان تُخرج براعم صغيرة لا حصر لها، ثم، دون معرفة متى، تتفتح مجموعات من الزهور الأرجوانية، وتمتزج بأوراق الشجر الصغيرة المبللة. لعدة أشهر، كانت حديقة الزان الخاصة بي مليئة دائمًا برائحة أزهار الزان اللطيفة. في ليالي الربيع العاصفة، كانت الرائحة تنتشر على نطاق واسع، وتملأ عدة غرف من المنزل، وتزداد عطرًا مع مرور الليل. كلما سقطت أزهار الزان في جميع أنحاء الممرات، تحول الطقس إلى برودة لطيفة ورذاذ خفيف. في ذلك الوقت، بغض النظر عن مدى انشغال جدتي، كانت تغتنم الفرصة للذهاب إلى السوق الخضراء لشراء بضع سلال من صلصة السمك ثم تعود لطحنها وتخميرها لصنع صلصة غمس طوال العام. قالت إن موسم زهور الزان الجديد كان ممتلئًا وأضفى على صلصة السمك رائحة خاصة لا يمكن لأي موسم آخر أن يضاهيها. عندما كانت أغصان الزان تتدلى منها ثمار خضراء صغيرة مستديرة، كانت علامة على اقتراب عطلة الصيف. كانت تلك أيام طفولتي السعيدة، أنتظر بفارغ الصبر كل صباح وظهر، عندما كانت أسراب لا حصر لها من الطيور المهاجرة والعيون البيضاء تطير فجأة من مكان ما، تنقض في جميع أنحاء الحديقة، ثم تطير فجأة بعيدًا دون سبب. في لحظة، عادت وهبطت برفق مثل دخان أصفر باهت من السماء، ترفرف فوق قمم الزان الخضراء. بدا زقزقتها وحفيف أوراقها لطيفًا على الأذنين مثل أغنية ريفية لطيفة. لو لم يكن صدى هدير المدافع العرضي قد تردد من مكان بعيد، لكان مشهد قريتي في ذلك الوقت سلميًا حقًا، مليئًا بالسعادة حقًا.
أعرف أن عمي هوان والآنسة شوان تواعدا رسميًا في ذلك الصيف، وعقدا قرانهما. قضيا ليالٍ طويلة يتهامسان بالحب في حديقة شوان خلف المنزل. فقط عندما غمر ندى الليل شعرهما، فتح عمي باب غرفة النوم برفق، وزحف إلى الداخل، وسحب الغطاء فوق رؤوسنا. عندما كان متحمسًا، نكز وركي، مما جعلني أشعر بألم في وركي، ثم همس بلهفة: "هل تريد أن تكون الآنسة شوان خالة زوجك؟". بصراحة، في ذلك الوقت، كنت أرغب فقط في النوم. أتذكر أنه في نهاية ذلك الصيف، أقامت العائلتان رسميًا حفل خطوبة لعمي وعمتي. لو كان كل شيء هادئًا، لما انتظرنا سوى بضع سنوات أخرى حتى تصبح حديقة شوان قديمة بما يكفي لقطع الأخشاب لبناء منزل، وحتى يُنهي عمي وخالتي دراستهما الثانوية، عندها سيتمكن عمي من تحقيق حلمه بإحضارها إلى المنزل. لكن في ذلك الوقت، كانت الحرب في قريتي مستعرة للغاية. كانت هناك غارات صغيرة حيث أرسل الفرنسيون قوات إلى القرية لصيد الدجاج والبط. أُجبر بعض الشباب على الانضمام إلى الميليشيات. رأى جدي الوضع غير الآمن، فأرسل عمي هوان سرًا إلى المنطقة المحررة في المنطقة الرابعة لمواصلة دراسته. اضطرت الآنسة شوان، وهي فتاة، إلى ترك الصف الخامس للعودة إلى المنزل والمساعدة في أعمال المزرعة. وغني عن القول أن عمي وخالتي كانا حزينين في ذلك الوقت. كانت ليلة وداعهما تحت مظلة أشجار شوان، التي كانت مزهرة بأوراقها الخضراء. ظننت أن الأيام القادمة ستكون بائسة لأنهما اشتاقا لبعضهما البعض لدرجة أن قلبيهما كانا يحترقان. صاحت دجاجة الجار عدة مرات قبل أن يدخل عمي المنزل. كان مدفونًا بالفعل تحت الغطاء، لكنه لم ينم. سمعته مستلقيًا بجانبي يتنهد ويتقلب. ثم في صباح اليوم التالي، توفي بهدوء. لم أتوقع أن تكون تلك الليلة الأخيرة التي سننام فيها أنا وعمي معًا. ولم يتوقع عمي أن تكون تلك الليلة التي سيغادر فيها إلى الأبد. ولم تتوقع الآنسة شوان أن تبكي بحرقة على عمي طوال حياتها، على فراق حبها الأول. ثم حلّت الكارثة بعائلتي فجأة.
في صباح أحد الأيام في أوائل شهر مارس من العام التالي، كانت السماء تمطر رذاذًا، وكانت الرياح، على الرغم من تأخر الموسم، لا تزال باردة وتعوي بلا انقطاع على قمم أشجار الزان التي أزهرت للتو أوراقًا جديدة، وكانت أزهار الزان أرجوانية على أطراف الفروع، تتلألأ بقطرات ماء كثيرة مثل دموع الأقارب الذين يبكون ويودعون بعضهم البعض. داهم الفرنسيون القرية فجأة. كان على جدي في ذلك العام، على الرغم من أنه لم يتجاوز الخمسينيات من عمره، أن يربي لحية لمحاربة الغارة مثل معظم الرجال في منتصف العمر في ذلك الوقت. على الرغم من أنه لم يكن كبيرًا في السن، فقد حاول إظهار أنه كبير في السن. حتى لا يجند الفرنسيون الجنود أو العمال. لكن لحية جدي كانت سوداء داكنة. كانت لديه لحية صغيرة على ذقنه، لكن لحية شفته العليا كانت كثيفة جدًا ومجعدة على جانبي فمه. لقد بدا أكثر شراسة وتمردًا، ولم يكن عجوزًا أو هرمًا على الإطلاق. خلال تلك الغارة، جمعوا جميع القرويين في المنزل الجماعي، وأعلنوا إنشاء ميليشيا، وبحثوا عن أشخاص على استعداد للركوع واتباعهم. ولما رأوا مظهر جدي الشرس، عيّنوه رئيسًا للجنة البلدية. قاوم جدي بحزم حتى النهاية، مصممًا على الموت بدلاً من أن يصبح خادمًا للعدو. ولما عجز الفرنسيون عن الاستسلام، جرّوا جدي إلى طريق القرية، ودفعوه إلى حديقة خوان الخاصة بعائلتي، وأطلقوا عليه النار عدة مرات في صدره. سقط جدي على وجهه على أرض الحديقة، أمام جدتي وأحفادي والقرويين الذين كانوا ينوحون بحزن. وفي فترة ما بعد الظهر، تراجعوا إلى مركز الشرطة، وساعد القرويون جدي على النهوض. كانت ذراعاه لا تزالان ملفوفتين بإحكام حول شجرة خوان صغيرة. بكى عمي وصلى لفترة طويلة قبل أن يتمكن من تحرير أصابعه العشرة من الشجرة. منذ تلك اللحظة المقدسة، نقشتُ في قلبي طوال حياتي تلك اليد القوية، تلك اليد ذات الأصابع العشرة الصلبة كالحديد، التي احتضنتني وواسيتني برقة، والتي تشبثت بأرض القرية طوال حياتي لأعيش حياة كريمة، لأعيش وفق الأخلاق الكونفوشيوسية التي غرستها عائلتي ودرّبتها أجيالاً. عندما وُضع الجثمان في النعش، كانت عيناه لا تزالان مفتوحتين على مصراعيهما، فلم يستطع عمي أن يداعبهما. غطّت جدتي عينيه بكلتا يديها، ثم انحنت ساجدةً، تعانق النعش وتبكي. بعد برهة، وكأن سحراً قد حل، تدفقت دمعتان غائمتان من زاويتي عينيه وتدفقتا عبر أصابع جدتي. بعد بضع لمسات خفيفة منها، أغمض جفنيه ببطء. على الرغم من جسده المشوه، أصبح وجه جدي في تلك اللحظة هادئاً على غير العادة. في ذلك الوقت، لم يجرؤ أحد على إغلاق غطاء النعش. من يطيق دفن رجل عجوز ينام قيلولة بعد الظهر؟ لأن شائعةً سرت بأن العدو سيقتحم القرية في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، في تلك الليلة تحديدًا، أقام جميع القرويين وعائلتي جنازةً لتشييع جثمان جدي إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة وسط الحقل. ولم يخطر بباله قط، طوال حياته، أنه عند وفاته، ستُقام جنازته على عجل في ليلة هادئة دون طبول أو أبواق. وربما لم يخطر بباله أيضًا أن القرية بأكملها ستودعه بعد وفاته، حزنًا عليه وإعجابًا به كبطلٍ ضحى ببسالةٍ في وجه العدو.
بعد أيام قليلة، وصل الخبر السيئ إلى عمي هوان. ولأن السفر بين المنطقة الحرة ومنطقة الميليشيا كان صعبًا وخطيرًا للغاية، لم تسمح جدتي لعمي هوان بالعودة إلى المنزل للحزن على والده. بعد بضعة أشهر، أرسل عمي رسالة عبر شخص موثوق يطلب من جدتي وعمي الإذن بترك الدراسة والانضمام إلى الحرس الوطني. كما تلقت عمتي شوان رسالة من عمي. لم أكن أعرف ما حُكي في الرسالة، لكنني رأيتها يوميًا تذهب بجدية لزيارة جدتي، تساعدها في طحن الأرز، وجمع عشبة الماء لعش الخنزير، تمامًا كزوجة ابن صالحة في عائلتي. مع أنني كنت لا أزال صغيرًا في ذلك الوقت، إلا أنني لاحظت أيضًا أنها أصبحت شخصًا مختلفًا هذه الأيام، غالبًا ما تنظر بعينيها شاردتين إلى مكان ما بنظرة تارة بعيدة وتارة حزينة. جميع فتيات القرية البريئات والمرحات في الماضي قد اختفين الآن. خلال تلك الفترة، لم تحتل قريتي قط من قبل الفرنسيين كما أرادوا. كان الوضع دائمًا تحت سيطرة فيت مينه ليلًا، والميليشيات نهارًا، مُربكًا حتى انتصار ديان بيان فو . تمتع نصف البلاد بالسلام والاستقلال. وغني عن القول، كان أهل قريتي سعداء. لكن عائلتي، عمي هوان، لم تعد أبدًا. يرقد في قلب مقبرة شهداء ديان بيان . على جدار الغرفة الوسطى من منزلي، منذ ذلك الحين، وُضعت شهادة تقدير من الوطن. أصبحت جدتي أمًا لشهيد قبل أن تبلغ الستين من عمرها، لكن شعرها قد شحب دون أن يعلم أحد متى. منذ ذلك العام، لا تزال السيدة شوان تنعى عمي بصمت إلى الأبد في قلبها البريء، الذي كان يحمل الكثير من الأحلام الجميلة قبل بضعة أشهر فقط.
عندما أعيد فتح المدارس، قمعت السيدة شوان حزنها وواصلت الدراسة. كان هناك تغيير: كان نفس المسار، ولكن الآن كل يوم كانت الوحيدة التي تمشي وحدها، ظل وحيد. لم تعد خطواتها متحمسة. وكانت كتفيها، التي اعتاد عمي أن يمتدحها دون تردد، جميلة مثل أكتاف قديس في لوحة دينية، لكنها الآن تقلصت إلى xoro صغير، غير قادرة على تجنب البرد القارس بين السماء الشاسعة والأرض كل صباح من ندى الخريف. بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، واصلت دراسة علم التربية ثم درّست في المنطقة. في أيام الأحد، كانت لا تزال تأتي إلى منزلي. كانت جدتي وهي تتحدث طوال الليل مثل الأم وابنتها. في العديد من ليالي الشتاء وجدتها جدتي تتجول في حديقة xoan. كان البرد والصقيع قاسيان للغاية، وكانت أشجار xoan التي لم تعد تحتوي على أوراق خضراء لتغطيها، واقفة عارية، مثيرة للشفقة. روحها الفارغة أم جذوع أشجار xoan التي كانت تقف عارية في ريح الشتاء، من كان أكثر برودة؟ في ليالٍ كهذه، كانت جدتي تُشعل البخور على مذبح جدي وعمي هوان، ثم تجلس وتُنوح على نفسها قائلةً: "يا مساكين يا أولادي". أعلم أن جدتي نصحتها مرارًا بتكوين أسرة. ولم تُنصت إليها إلا بعد سنوات.
في وقت متأخر من ظهيرة أحد الأيام من العام، غارقة في الرذاذ والرياح الشمالية الباردة، جاءت إلى منزلي، تبكي، وتطلب الإذن من جدتي لإشعال البخور أمام مذبح جدي وعمي هوان. ثم وقفت هناك، تعانق جدتي، تبكي، غير قادرة على الكلام. كان على جدتي أن تحل محلها، وهي تبكي وتختنق هي الأخرى، وتصلي وداعًا بشكل متقطع، وتطلب الإذن من جدي وعمي للسماح لها بالزواج من شخص ما. في نهاية الربيع التالي، أقام السيد والسيدة لانغ كينه حفل زفافها. كنت أيضًا حاضرًا في المجموعة التي اصطحبتها إلى منزل زوجها على الجانب الآخر من نهر كاي. مر موكب الزفاف ببطء عبر بوابة منزلي. تحركت العروس على مضض، واتخذت خطوات قصيرة وثقيلة تحت ظل أشجار خوان القديمة، التي كانت أزهارها الأرجوانية لا تزال ترفرف على الأغصان. فجأة، هب نسيم، بدا وكأنه تنهد من مكان بعيد، مما تسبب في سقوط عدد لا يحصى من الزهور الأرجوانية مثل المطر على قبعة العروس، التي تتشبث بإحكام بأكتاف فستان زفافها. نظرت الآنسة شوان شارد الذهن بعينيها الحزينتين. في الأعلى، ارتجفت أغصان شجرة شوان، ولوحت بأذرعها وداعًا، إلى جانب العديد من الأوراق الخضراء التي حفيفًا في انسجام، تغني كلمات البركة التي يمكن أن تشعر بها هي فقط بشكل غامض. تبعتها عن كثب، وشعرت أيضًا بشكل غامض أن شيئًا مقدسًا قد حدث للتو. تشبثت أزهار شوان الأرجوانية بإحكام بجسد العروس، رافضة السقوط على الأرض. من الآن فصاعدًا، ستحضرها إلى منزل زوجها. ستعيش حياتها كلها في وهم برائحة أزهار شوان الحلوة. ستقضي حياتها كلها تشعر بالحزن كل عصر خريف، تحدق في وطنها البعيد عبر النهر.
كان من روى لي هذه القصة صبيًا صغيرًا آنذاك. أما الآن فهو رجل عجوز يقارب السبعين. غاب عن المنزل ثلاثين عامًا. قبل بضع سنوات فقط، أتيحت لي فرصة العودة إلى مسقط رأسي القديم. كل خطوة أخطوها على طريق القرية تملأ قلبي بذكريات مؤثرة كثيرة. أشجار الزان التي كرّس جدي حياته لها تحمي الآن سعادة زوجين بكل حب! الحديقة التي ورثتها عائلتي لأجيال أصبحت الآن ملكًا لشخص آخر. وجودي في هذا المكان الآن أشبه بغربة. في أحسن الأحوال، لا يزال في ذكريات كبار السن الباهتة. وفي عصر ذلك اليوم من تلك الزيارة الحزينة، التقيت بخالة عمي زان بجوار المكان الذي كانت تزدهر فيه حديقة الزان. إن التفكير في الماضي الآن يزيد من حزني الشديد والمرير. كانت قد أحضرت معها حفيدها، الذي كان في مثل عمري آنذاك. كان على رأسها وشاح حداد. قالت إن زوجها قد توفي للتو. لقد كانت امرأة عجوزًا منذ زمن طويل. بدت أكتافها المقدسة منحنيةً تحت وطأة الحياة. لم يبقَ منها إلا عيناها. قرأتُ فيهما بريقًا عاطفيًا لحديقةٍ قديمةٍ رومانسيةٍ دائمة الخضرة من أشجار الزان.
يا لها من حديقة خالدة من زهور الزان. حديقة الذكريات التي تحدّت تقلبات الحياة والموت، وتحدّت سنوات البلى والتلف. الآن، هذه مجرد قطعة أرض هامدة وخالية عند أقدام ابنة أختنا. ابتسمت بحزن وقالت إنني أشبه عمي هوان كثيرًا. قلتُ أيضًا إنها لا تزال الآنسة زان من حديقة الزان القديمة. بدا وكأن رائحة زهور مألوفة كانت تملأ المكان. هل كانت رائحة زهور الزان الأرجوانية التي علقت بقبعتها وكتفيها في عصر ذلك الربيع المتأخر عندما أخذتها بحزن إلى منزل زوجها ذلك العام؟ هل كانت روح جدي وعمي هوان التي كانت تعود ببطء؟
سيظل عمي هوان حبيبًا صغيرًا. وأنا وأختي شوان، ابنة أختي، على وشك أن ننتهي من حياتنا كبشر.
في تي كيه
مصدر






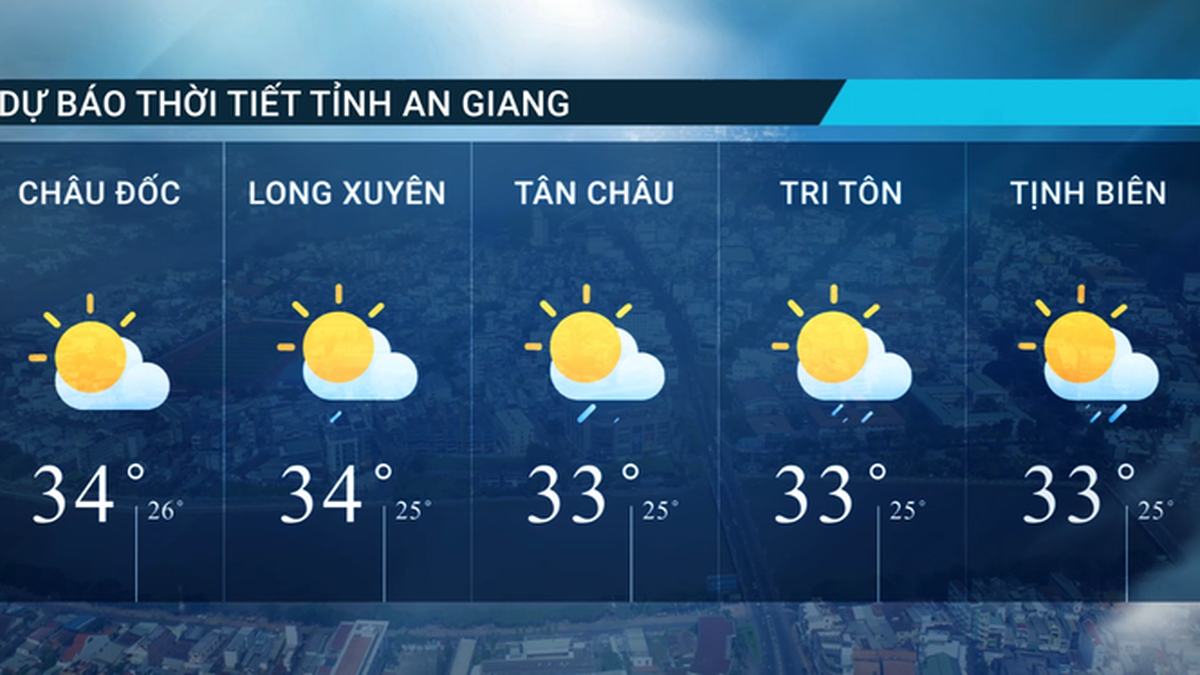

































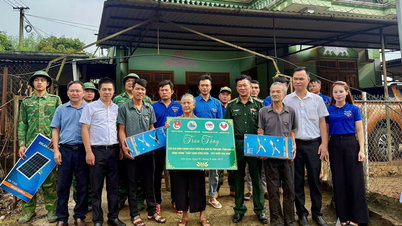
























































تعليق (0)