(VHQN) - في فترة ما بعد الظهر الصيفية الهادئة، كانت الفتاة الصغيرة مستلقية على أرجوحة معلقة بين شجرتي تمر هندي بهما فاكهة خضراء ثقيلة، وكان خدها على الطرف الآخر، وكانت إحدى ساقيها مستقيمة وطويلة حتى تتمكن الفتاة الصغيرة من احتضانها بإحكام، وكانت الساق الأخرى معلقة بشكل فضفاض على الأرض، تتأرجح في الأرجوحة: "تهويدة، يا صغيرتي، للنوم/ أشاهدك تكبر لتصبح شخصًا حكيمًا".

حاولتُ إقناع نفسي بالبقاء مستيقظةً والتحدث إلى أمي، لكنّ الأناشيد العذبة التي تُهبّ في النسيم العليل لا تزال تُهدهد الطفلة الصغيرة وتُدخلها في حلمٍ هادئ. كانت تلك أيام الصيف النادرة التي تُغني فيها أمي لي وأنام.
عندما استيقظتُ فجأةً من قيلولتي بعد الظهر، وركضتُ أبحث عن أمي، كانت الرائحة المألوفة قد حلّقت مع الريح في مكانٍ ما. حملت أمي عصاها على كتفها وغادرت المنزل إلى المدينة لتجمع كل ما تستطيع من مال لإطعام جميع أفراد الأسرة.
ربما ولدت هذه التهويدة في نفس وقت ولادة الأطفال، محتوية على الحب اللامحدود من جداتهم وأمهاتهم، ولهذا السبب فهي حلوة وطويلة الأمد.
أول درس علمتني إياه الحياة في الرابعة من عمري هو القبول. مهما اشتقت لأمي، ومهما شعرت بالفقد والخوف من الهجر، ما زلت أحاول تقبّل حقيقة أنها لا تستطيع أن تكون بجانبي دائمًا.
إن كفاحنا لكسب عيشنا كبالغين يُجبر آباءنا على تركنا مؤقتًا. وفي طريقنا إلى الرشد، سيأتي وقتٌ يحتاج فيه الأطفال إلى فسح المجال لوالديهم ووداعهم.
الشيء الوحيد الذي هداني خلال الأيام غير المؤكدة لتعلم اللعب والنوم بمفردي كان تهويدة أمي الحنونة التي هزتني بها برفق في الأرجوحة ذات بعد ظهر: "في يوم من الأيام، كنت طفلاً صغيراً/ والآن كبرت هكذا/ أرز الأب، ملابس الأم، كلمات المعلم/ فكر في كيفية تعويض أيام الشوق".

زعم أحدهم ذات مرة أن المرأة الفيتنامية ستعرف تلقائيًا كيف تُغني تهويدة ما دامت تلد. فهل يُعقل إذن أن التهويدات وُلدت مع الأطفال، حاملةً حب أمهاتهم وجداتهم اللامحدود، ولذلك تبقى عذبةً وعميقةً؟
عندما لا نفهم شيئًا بعد، تُنسج التهويدات برائحة أول شخص يحمل الطفل، وتُغلف التهويدات بصوت كل أم لطيف، وتحمل التهويدات الشكل المألوف للريف.
في حلم ما بعد الظهر، هناك طائرات ورقية تحلق في الريح، وهناك شكل نحيف لمزارع يحمل الشمس على ظهره في الحقل، وهناك صوت الناي يقود الجاموس إلى المنزل، وهناك طيور اللقالق تنادي غروب الشمس إلى سياج الخيزران في القرية...
عندما كبرت قليلاً، كانت تُسمع أناشيد الأطفال وجريهم ولعبهم. كنتُ أيضاً من أولئك الأطفال الذين يلعبون لعبة القفز على المربعات أمام الشرفة، أُدندن وأُقلّد أغنية أمي: "على الفتاة في المنزل أن تُعنى بالأعمال المنزلية/ مظهرها رشيق، رقيق، ولطيف/ عندما تأكل، عندما تتكلم، تكون ناضجة/ عندما تجلس، عندما تقف، تكون رشيقة ورشيقة".
التهويدات ليست مجرد تهويدات، بل هي تعاليم القدماء، تُغذي الروح وتُصقل الشخصية. تُعبّر الأغاني الشعبية عن حب الريف، وتُعبّر عن المودة العائلية، وتُشارك وجهات نظر حول الحياة من حولنا أو كيفية التعامل مع الآخرين.
وبسبب ذلك، ورغم أنني أفتقد في بعض الأحيان يد أمي، إلا أنني لا أزال أستطيع أن أكبر بفخر بفضل الترنيمة الحلوة المحفورة بعمق في عقلي الباطن: " في كل عصر أفتقد عصر اليوم/ أفتقد قدر الأرز البارد، أفتقد قدر الشاي/ أفتقد الوقت الذي صعدت فيه على الحصان ونزلت منه/ أفتقد قدر الشاي، أفتقد قدر السكر ".
رافقتني تهويدة تلك الأيام نيابةً عن أمي طوال حياتي، داعمةً كل خطوة، ومُغلفةً كل ذكريات جذوري. خلال منفاي، وأنا أتجول بين حشود الغرباء في الشوارع مراتٍ لا تُحصى، كانت تلك التهويدة هي التي ذكّرتني بأن أمي لا تزال تنتظرني ليلًا نهارًا في وطني البعيد: " عندما ترحل، يكون والدك خائفًا، وأمك قلقة/ النهر عميق، والمياه عالية، والعبّارة لا تُقلّك/ النهار يتقدم أكثر فأكثر/ عيناي مُرهقتان من الانتظار، لكنك لم تعد بعد "...
في صغرنا، كان كل طفل يتمنى أن يكبر سريعًا لنتجول بحرية. وعندما كبرنا، كنا نتوق إلى أمسيات صيف طفولتنا، عندما كانت جدتنا وأمنا تُهدئاننا بأغانيهما المحببة. وكنا نتوق للعودة حتى لو كان ذلك في حلم نصف يقظة.
ليس لديّ موهبة موسيقية ، ولا أملك مخزونًا من الأغاني الشعبية والأغاني الشعبية في ذاكرتي كما فعلت أمي. لكنني أؤمن دائمًا أنه عندما يولد طفلي، ستأتي التهويدة تلقائيًا.
سأهدّئ طفلي لينام، لأجد أمي، لأجد ذاتي من الأيام الخوالي. "أوه، في داو كاو بي دوت تروي"، تهويدة، تهويدة أيضًا وسيلة لتهدئة قلبي في شوق لا ينتهي للحياة.
[إعلان 2]
مصدر








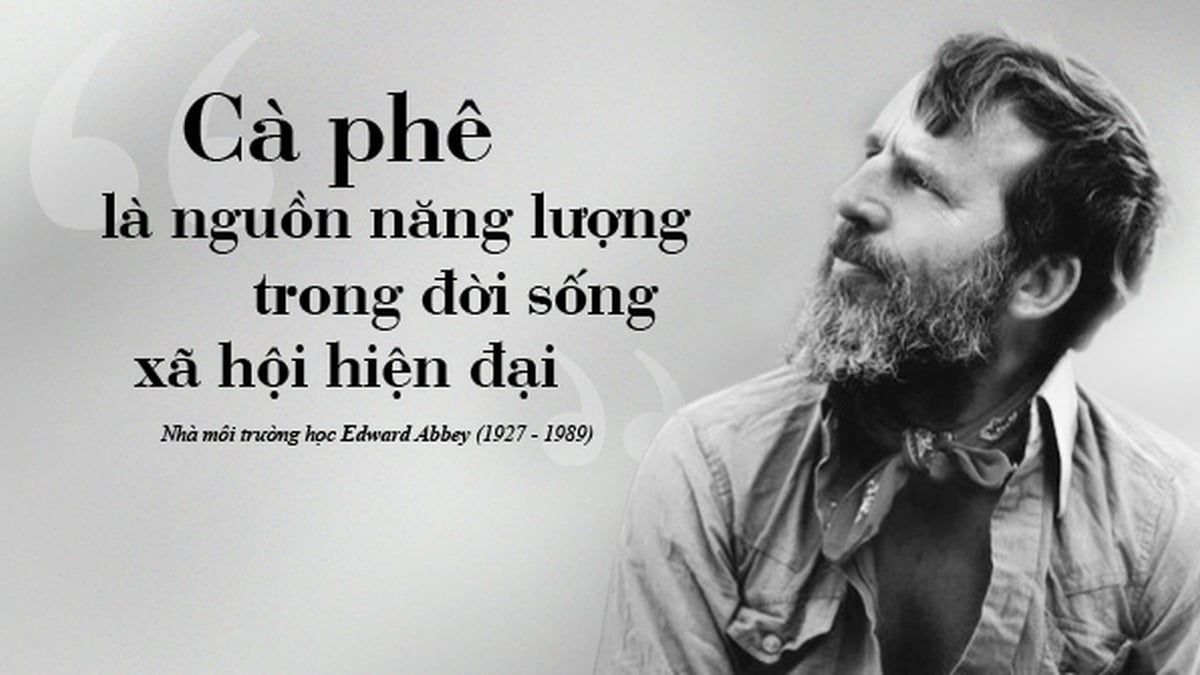
















![[صورة] رئيس الجمعية الوطنية يحضر ندوة "بناء وتشغيل مركز مالي دولي وتوصيات لفيتنام"](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
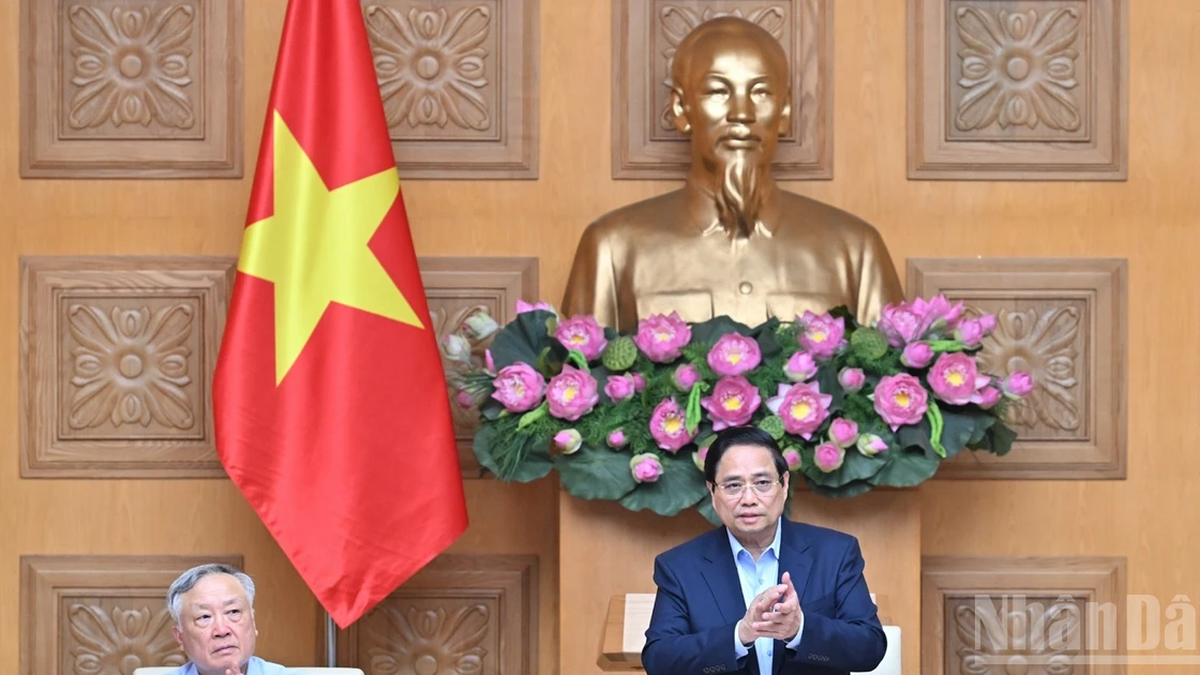











































































تعليق (0)