
حتى اليوم، ما زلت أتذكر كلمات الجنرال دوونغ فان مينه والعميد نغوين هو هانه التي ألقيت على إذاعة سايغون في الساعة 9:00 صباحًا يوم 30 أبريل 1975: "...نطلب من جميع جنود جمهورية فيتنام التزام الهدوء، ووقف إطلاق النار، والبقاء في أماكنهم لتسليم السلطة إلى الحكومة الثورية بطريقة منظمة وتجنب إراقة دماء مواطنينا بلا داعٍ."
لقد كانت فرحة كبيرة أن الحرب انتهت في لحظة، وأن سكان سايغون كانوا بأمان، وأن المدينة ظلت سليمة.
في ظهيرة يوم 30 أبريل، غادرت منزلي في المنطقة 3 لزيارة والدتي في ثي نغي.
عائلتي لديها تسعة إخوة، وخمسة منهم خدموا في جيش فيتنام الجنوبية: أحدهم أصبح جندياً معاقاً في عام 1964، وتوفي أحدهم في عام 1966، وكان أحدهم رقيباً، وكان أحدهم جندياً، وكان أحدهم ملازماً.
كان أخواي الأكبر سناً قد حصلا على أرقامهما العسكرية؛ ولم يبقَ سوى أخي الأصغر بالتبني وأنا بدونها. في ذلك اليوم، عندما رأتني أمي، كتمت دموعها وقالت: "إذا استمرت الحرب، فلا أدري كم من الأبناء سأفقد".
بعد مغادرتي منزل والدتي، ذهبت إلى جامعة فو ثو للتكنولوجيا (جامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا حاليًا) للتحقق من الوضع.
في ذلك الوقت، كنت ثالث أعلى شخص في فريق القيادة بالمدرسة، وكان قائد الفريق قد سافر إلى الخارج قبل بضعة أيام.
عند دخولي البوابة، رأيتُ عدداً من الموظفين يرتدون شارات حمراء يقفون حراساً لحماية الجامعة. شعرتُ بالارتياح لرؤية أن جامعة التكنولوجيا سليمة وآمنة.
يصعب وصف فرحة رؤية السلام يعم بلادنا، وحتى بعد مرور خمسين عامًا، ما زلت أشعر بالسعادة. بحلول عام ١٩٧٥، كانت الحرب قد استمرت ثلاثين عامًا، أي أطول من عمري آنذاك الذي بلغ ثمانية وعشرين عامًا. لقد وُلد جيلنا ونشأ في ظل الحرب؛ فأي فرحة أعظم من السلام؟
بعد أيام السلام والوحدة السعيدة، حلت مصاعب لا حصر لها. تدهور الاقتصاد ، وأصبحت الحياة صعبة، وتركت حروب الحدود في الجنوب الغربي مع الخمير الحمر وحرب الحدود عام 1979 في الشمال مع الصين الكثير من الناس يشعرون بالكآبة، واختار الكثيرون الرحيل.
ما زلتُ أحاول التفاؤل بشأن سلام البلاد؛ فأنا ما زلت شابًا وأستطيع تحمّل المشاق. لكن عندما أنظر إلى طفلتي، لا يسعني إلا أن أشعر بالحزن الشديد. رُزقتُ أنا وزوجتي بابنة أخرى في نهاية نوفمبر عام ١٩٧٦، ولم يكن لديها ما يكفي من الحليب، فأعطى حماي حصته من الحليب لحفيدته.
لم تكن رواتبنا الحكومية كافية للعيش، لذا اضطررنا لبيع ما استطعنا بيعه تدريجياً. كانت زوجتي تُدرّس اللغة الإنجليزية في جامعة المصارف، وفي مركز التدريب التقني التابع لجمعية المثقفين الوطنيين، كما كانت تُعطي دروساً إضافية في العديد من المنازل الخاصة، وتقطع عشرات الكيلومترات بالدراجة حتى وقت متأخر من الليل.
أما أنا، فأركب دراجتي في الصباح الباكر لأوصل طفليّ إلى منزل جدتهما في مقاطعة بينه ثانه، ثم أتوجه إلى جامعة البوليتكنيك في المقاطعة العاشرة للتدريس. وعند الظهر، أعود لأوصل ابني إلى مدرسة لي كوي دون في المقاطعة الثالثة، ثم أعود إلى عملي في الجامعة.
في فترة ما بعد الظهر، كنت أعود إلى مقاطعة بينه ثانه لأصطحب ابنتي، ثم أعود إلى منزلنا في حي ين دو السكني، بالمقاطعة الثالثة، حيث كانت زوجتي تصطحب ابننا. كنت أقطع بالدراجة أكثر من ٥٠ كيلومترًا يوميًا على هذا المنوال لعدة سنوات. في أوائل الثمانينيات، فقدت أكثر من ١٥ كيلوغرامًا، وعدت إلى نحافتي التي كنت عليها عندما كنت طالبًا.
لم تكن الصعوبات والنواقص هي الأمور المحزنة الوحيدة؛ بالنسبة لنا نحن المثقفين من الجنوب، كانت العاصفة النفسية أكثر خطورة.
في سن الثامنة والعشرين، وبعد عودتي إلى فيتنام بعد أقل من عام من سبع سنوات من الدراسة في الخارج، وشغلي منصب مساعد العميد في جامعة التكنولوجيا آنذاك - وهو ما يعادل منصب نائب رئيس جامعة البوليتكنيك الحالية - تم تصنيفي كمسؤول رفيع المستوى وكان عليّ تقديم تقرير إلى اللجنة العسكرية الحاكمة لمدينة سايغون - جيا دينه.
في يونيو 1975، صدرت لي أوامر بالالتحاق بمعسكر إعادة تأهيل، لكنني كنت محظوظًا. في يوم وصولي، كان العدد كبيرًا جدًا، فتأجل الأمر. وفي اليوم التالي، صدر أمر بتخفيض رتبة العاملين في قطاعي التعليم والصحة الذين كان عليهم الالتحاق بمعسكرات إعادة التأهيل درجة واحدة، لذا لم أضطر للذهاب.
رحل أصدقائي وزملائي واحداً تلو الآخر، لأسباب مختلفة، لكنّ الحزن كان يخيم على الجميع، وتخلي الجميع عن طموحاتهم. وبحلول عام ١٩٩١، كنتُ الحاصل الوحيد على شهادة الدكتوراه الذي تلقى تدريبه في الخارج قبل عام ١٩٧٥ في جامعة البوليتكنيك، والذي بقي للتدريس حتى تقاعدي في أوائل عام ٢٠٠٨.
بعد أن ارتبطت بجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا لأكثر من 50 عامًا، وشاركت في رحلتها التاريخية وعشت الفرح والحزن، وحتى اللحظات المريرة، لم أندم أبدًا على قراري بترك حياة مريحة ومستقبل علمي واعد في أستراليا للعودة إلى الوطن في عام 1974 والبقاء في فيتنام بعد عام 1975.
اخترت العمل كمحاضر جامعي برغبة في مشاركة معرفتي وفهمي مع طلاب الجامعة، والمساهمة في تنمية البلاد، وإيجاد راحة البال من خلال التفاني في خدمة وطني والوفاء بمسؤولية المثقف.
على مدى 11 عامًا كرئيس لقسم هندسة الطيران، وضعت الأساس لتطوير الموارد البشرية في صناعة هندسة الطيران في فيتنام، وساهمت في تدريب أكثر من 1200 مهندس، منهم أكثر من 120 مهندسًا تابعوا دراساتهم العليا للحصول على درجة الدكتوراه في الخارج.
إنه لمن دواعي سروري وفخري الأكبر أنني شاركت في إطلاق برنامج "من أجل غد متطور" لصحيفة توي تري، بدءًا من عام 1988، ومنذ ذلك الحين كنت "رائدًا" في تمكين أجيال عديدة من الطلاب.
فيما يتعلق ببرنامج المنح الدراسية "دعم الطلاب في المدارس"، فقد توليت مسؤولية جمع التبرعات لمنطقة ثوا ثين هيو لمدة 15 عامًا. وقد ساهمت عشرات الآلاف من المنح الدراسية، التي بلغ مجموعها مئات المليارات من عملة الدونغ الفيتنامية، في فتح آفاق مستقبلية لعشرات الآلاف من الشباب.
بفضل مساهمتي في مستقبل فيتنام، تلاشت تدريجياً مشاعر الوحدة التي شعرت بها خلال الأيام الصعبة التي أعقبت عام 1975.
خلّفت ثلاثون عاماً من الحرب ملايين العائلات بخسائر فادحة، وأرست وراءها كراهية عميقة، وتعصباً، وسوء فهم. أما خمسون عاماً من السلام، في ظل وطن فيتنامي مشترك، وعمل جماعي لتحقيق هدف مشترك لمستقبل البلاد، فقد أتاحت للروابط الأسرية أن تتجاوز الكراهية والتعصب.
لسنوات عديدة، وجدت نفسي عالقاً بين طرفين: في الداخل، كنت أُعتبر مؤيداً للنظام الفيتنامي الجنوبي القديم؛ وفي الخارج، كنت أُعتبر مؤيداً للنظام الاشتراكي. باختياري الهادئ لمبادئي التي تصب في مصلحة بلدي، أصبح أسلوب حياتي وعملي جسراً طبيعياً بين الجانبين.
على مدى الخمسين عاماً الماضية من السلام وإعادة التوحيد، قمت بتكوين العديد من العلاقات الوثيقة بين الناس من "هذا الجانب" و"ذاك الجانب"، وأنا فخور حقاً بأنني كنت جزءاً من المصالحة والوئام الوطنيين.
على المذبح في منزل جدتي في هوي، توجد ثلاثة أقسام: في المنتصف، في الأعلى، توجد صور أجدادي الكبار، ثم أجدادي من جهة الأب؛ على جانب واحد توجد صور أطفال أجدادي من جهة الأب الذين خدموا في جيش التحرير؛ وعلى الجانب الآخر توجد صور أطفال آخرين خدموا في جيش فيتنام الجنوبية.
كانت جدتي تعاني من ضعف البصر، وفي سنواتها الأخيرة، ازداد بصرها سوءًا. أعتقد أن هذا كان جزئيًا نتيجة السنوات التي قضتها تبكي على أبنائها الذين ماتوا في الحرب.
أمام المنزل صفان من أشجار جوز التنبول وممر صغير يؤدي إلى البوابة. تخيلت جدّي وجدّتي واقفين عند البوابة، يلوّحان مودّعين أبناءهما ذاهبين إلى الحرب؛ وتخيلتهما أيضاً جالسين على الكراسي في الشرفة مساءً، يحدّقان في الأفق، ينتظران عودة أبنائهما؛ وهناك شهدتُ مشهداً مفجعاً لوالدين مسنّين يذرفان الدموع على أبنائهما الصغار في حزن لا يوصف.
لا تستطيع أن تفهم حقًا معاناة الانتظار الطويل والمؤلم للزوجات والأمهات اللواتي يغيب أزواجهن وأبناؤهن لفترات طويلة إلا الدول التي عانت من ويلات الحرب، مثل فيتنام. "يُصبغ الشفق الموحش بلون أرجواني، شفق لا يعرف الحزن. يُصبغ الشفق الموحش بحزن عميق" (هوو لوان).
كانت مصائر النساء خلال الحرب متشابهة؛ فقد سارت والدتي على خطى جدتي. كان والدي "يسافر بمجرد زواجنا"، وفي كل مرة يعود فيها إلى المنزل في إجازة، كانت والدتي حاملاً.
أعتقد أن والدي كان قلقاً خلال تلك السنوات أيضاً بشأن ولادة زوجته في المنزل، متسائلاً كيف ستسير الأمور وما إذا كان الأطفال سيولدون بصحة جيدة. لقد ربت والدتي الأطفال بمفردها.
ذات مرة، بينما كنت أسرع إلى المنزل سيراً على الأقدام قبل حظر التجول، انفجرت قنبلة يدوية بالقرب من قدمي؛ لحسن الحظ، أصبت فقط في الكعب.
كان جيل أمي أكثر حظاً لأنهم لم يضطروا إلا إلى انتظار أزواجهم، وكانوا أكثر حظاً لأن والدي عاد، والتقوا من جديد، ولم يضطروا إلى المرور بالحزن مثل جدتي، "التي كانت تجلس بجانب قبر طفلها في الظلام".
قصة عائلتي ليست استثنائية. فقد عرض عليّ صحفيون مرارًا وتكرارًا الكتابة عن أطفال عائلتي جدّي وجدّتي، لكنني رفضت، لأن معظم العائلات في الجنوب تتشابه في ظروفها. لقد عانت عائلتي من ألم أقل من كثيرين غيرها.
زرتُ مقابر الحرب في أنحاء البلاد، وكنتُ أتأمل دائمًا في الألم الهائل الكامن وراء كل شاهد قبر. زرتُ الأم ثو في كوانغ نام ذات مرة حين كانت على قيد الحياة. لاحقًا، كلما نظرتُ إلى صورة فو كونغ دين للأم ثو، وعيناها دامعتان، جالسةً أمام تسع شموع ترمز إلى أبنائها التسعة الذين لم يعودوا، تساءلتُ كم من الأمهات الأخريات مثل الأم ثو في هذه الأرض التي تشبه حرف S، فيتنام.
خلال عقود من السلام، ورغم وفرة الطعام، لم تُهدر أمي أي طعام متبقٍ. فإذا لم نُنهِ ما تبقى منه اليوم، كنا ندخره لليوم التالي. لقد غرست فينا عادة الادخار منذ الصغر، لأن "رمي الطعام تبذير؛ لم يكن لدينا ما يكفي من الطعام في الماضي". كانت عبارة "في الماضي" أكثر ما تردده أمي، تُكررها كل يوم تقريبًا.
الأمر المثير للدهشة هو أنه عندما تتحدث أمي عن الماضي – من سنوات القصف المدفعي إلى سنوات الشح الطويلة، حيث كان الأرز يُخلط بالبطاطا الحلوة والكسافا – فإنها تسترجع الذكريات فقط، ولا تتذمر أو تشكو. بل إنها تضحك أحيانًا من أعماق قلبها، مندهشة من قدرتها على تجاوز كل ذلك.
بالنظر إلى الماضي، فإن الشعب الفيتنامي، بعد أن مرّ بالحرب والمصاعب، أشبه ببذور الأرز. من المذهل كيف استطاعوا اكتساب هذه القوة والصمود والمثابرة من أجسادهم النحيلة الصغيرة، حيث كان الجوع أكثر شيوعاً من الشبع.
مرت خمسون سنة من السلام كلمح البصر. رحل أجدادي، ورحل والداي أيضاً. أحياناً أتخيل كيف كانت ستكون عائلتي لو لم تكن هناك حرب. يصعب عليّ التخيل بكلمة "لو"، لكن بالتأكيد ما كانت أمي لتُصاب بتلك الجرح في كعبها، وما كان والداي ليعيشا سنوات الفراق تلك، وكان مذبح أجدادي من جهة أبي سيُزين بالأردية نفسها...
بعد سقوط بون ما ثوت، اندفع الزمن، مثل حصان يركض، إلى الأمام، متجهاً مباشرة نحو يوم ربما لن ينساه أي فيتنامي على الإطلاق: الأربعاء، 30 أبريل 1975.
في غضون بضعة أيام، أوضحت التطورات في ساحة المعركة والساحة السياسية أن فيتنام الجنوبية ستسقط. انقسم معارف عائلتي إلى مجموعتين: الأولى سارعت إلى حجز تذاكر الطيران للفرار من فيتنام، والثانية راقبت الوضع بهدوء. وكانت المجموعة الثانية أكبر بكثير من الأولى.
في التاسع والعشرين من أبريل، بدا أن القتال قد هدأ، لكن وسط المدينة أصبح فوضوياً. هرع الناس إلى رصيف باخ دانغ والسفارة الأمريكية، متخبطين بحثاً عن مكان يغادرون إليه.
في صباح يوم 30 أبريل، تدفقت الأخبار. في الأزقة أمام منزلي وخلفه، كان الناس يصرخون وينشرون الأخبار عبر مكبرات الصوت.
منذ الصباح الباكر:
"إنهم قادمون من كو تشي."
"لقد وصلوا إلى با كيو."
"إنهم ذاهبون إلى تقاطع باي هين"، "إنهم ذاهبون إلى بينه تشان"، "إنهم ذاهبون إلى فو لام"...
بعد الظهر بقليل:
"دباباتهم تتجه إلى هانغ زانه"، "دباباتهم تتجه نحو ثي نغي"، "الدبابات موجودة في شارع هونغ ثاب تو من حديقة الحيوان باتجاه قصر الاستقلال".
"إنهم يتحولون إلى قصر الاستقلال. يا إلهي، لقد انتهى كل شيء!"
لم تكن الأحداث التي تلت ذلك الصباح سوى إعلان رسمي لنهاية الحرب. فقد أعلن الرئيس دوونغ فان مينه الاستسلام عبر الإذاعة.
انتاب بعض الناس الذعر. ومع ذلك، راقبت معظم العائلات في الحي الوضع بهدوء وسكينة نسبية.
بحلول أواخر عصر يوم 30 أبريل 1975، بدأ الناس بفتح أبوابهم لتحية بعضهم البعض. كان سكان سايغون معتادين على الاضطرابات السياسية، لذلك شعر معظمهم بالاطمئنان مؤقتًا بسبب التغييرات التي لم يفهموها تمامًا.
في ذلك المساء، عقد والدي اجتماعاً عائلياً.
قال والدي: "أعتقد أنه من الجيد أنهم استولوا على المدينة. لقد كانت هذه الحرب ضخمة وطويلة، ومن الرائع أنها انتهت بسلام. على أي حال، فإن إعادة توحيد البلاد هو أكثر شيء مرحب به!"
قالت أمي: "لا أحد يريد أن تطول الحرب. الآن يمكن لوالديك أن يطمئنا إلى أن جيلكم سيعيش حياة أسعد مما عشنا".
وسط هذه الآمال والمخاوف بشأن المستقبل البعيد، وجدت عائلتي أيضاً أن عملية الاستيلاء سارت بشكل عام بسلاسة، حيث أظهرت الحكومة الجديدة حسن نية في منع النهب واستعادة النظام والاستقرار الاجتماعي.
في الأيام الأولى من شهر مايو عام 1975، كانت الشوارع مهجورة، كما هو الحال خلال رأس السنة القمرية، وفقدت نظافتها المعتادة. اختفى جيش كامل قوامه مئات الآلاف من رجال النظام الفيتنامي الجنوبي، والذين تم تسريحهم في اليوم السابق، دون أن يتركوا أثراً.
تجولت في سايغون ووجدت مكبات نفايات مليئة بمئات من الزي العسكري الجديد تمامًا تم التخلص منه على عجل، وآلاف من أزواج الأحذية الجيدة تمامًا ملقاة دون رقابة، وعدد لا يحصى من القبعات وقوارير المياه ملقاة بشكل عشوائي... في بعض الأحيان كنت أجد أسلحة مفككة وبعض القنابل اليدوية متناثرة على جانب الطريق.
خلال رحلتنا، صادفنا بين الحين والآخر بعض المركبات العسكرية الفيتنامية الشمالية، التي لا تزال مغطاة بأوراق التمويه. أينما ذهبنا، رأينا جنودًا ذوي مظهر وديع، بعيون واسعة حائرة، يراقبون، فضوليين، يستفسرون، ومفتونين.
أدى الشعور الأولي بالأمان وحسن النية إلى تفوق التأييد على المعارضة، والحماس على اللامبالاة. وكان الأمر المؤكد هو انتهاء الحرب.
--------------------------------------------------------------------------------
المحتويات: NGUYEN THIEN TONG - NGUYEN TRUONG UY - LE HOC LANH VAN
التصميم: فو تان
Tuoitre.vn
المصدر: https://tuoitre.vn/ngay-30-4-cua-toi-20250425160743169.htm












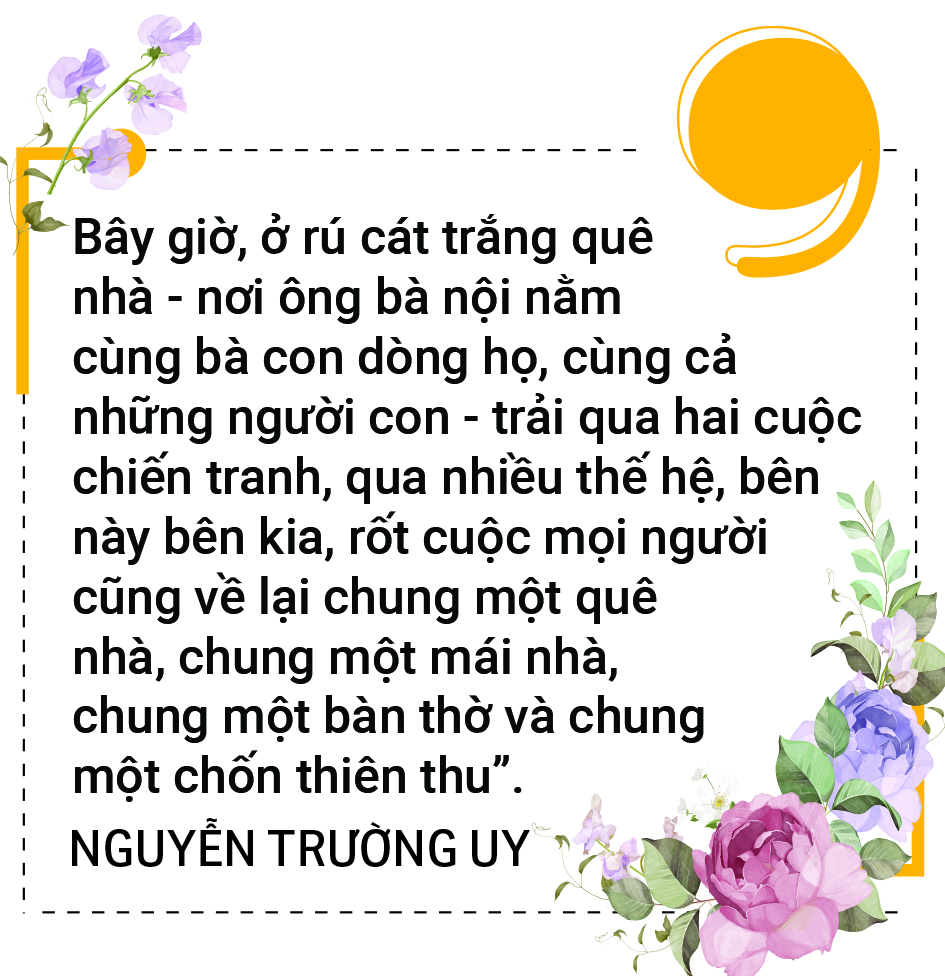



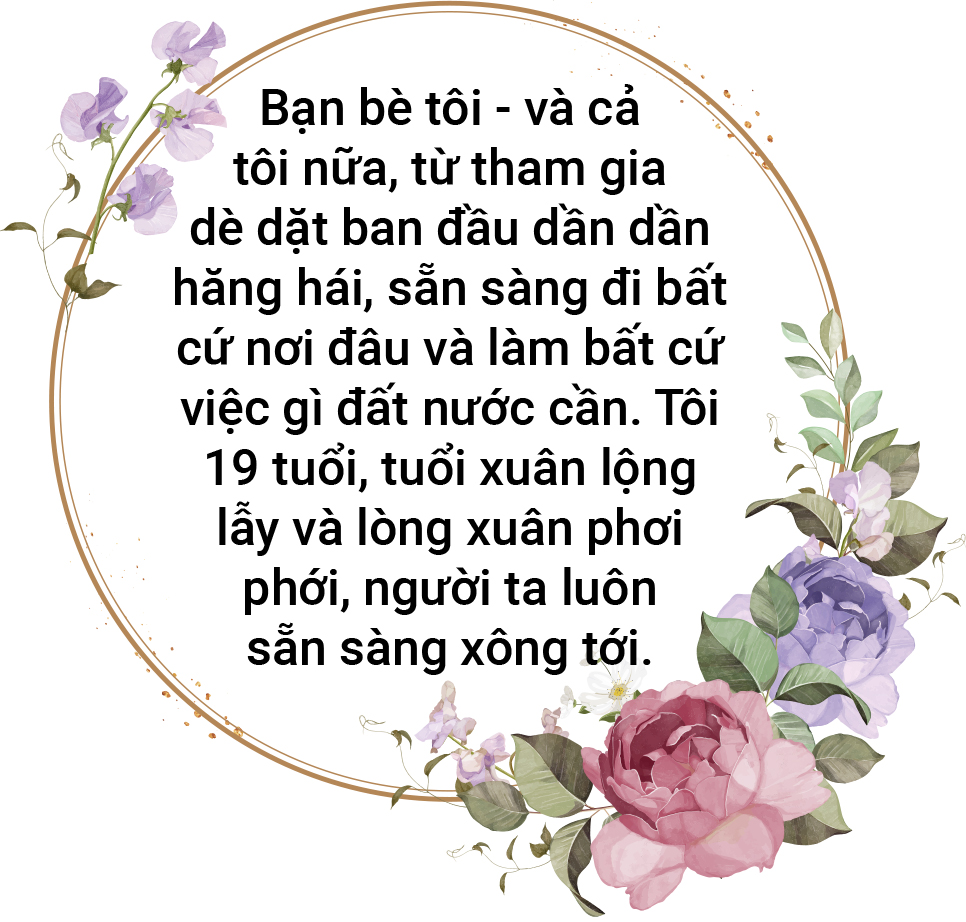



































![[صورة] الأمين العام تو لام يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس الصين شي جين بينغ](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F30%2F1769759383835_a1-bnd-5347-7855-jpg.webp&w=3840&q=75)

































































![OCOP خلال موسم تيت: [الجزء 3] ورق الأرز فائق الرقة يحقق رواجاً كبيراً.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F28%2F1769562783429_004-194121_651-081010.jpeg&w=3840&q=75)

![احتفالات عيد رأس السنة الفيتنامية (تيت): [الجزء 2] قرية هوا ثانه للبخور تتوهج باللون الأحمر.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769480573807_505139049_683408031333867_2820052735775418136_n-180643_808-092229.jpeg&w=3840&q=75)





تعليق (0)