عمل المؤلف مع السيدة هو ثي بيينغ، البالغة من العمر 83 عامًا، في هاملت 3ب، بلدة كي سان، التي كانت شاهدة على مذبحة راح ضحيتها 94 شخصًا في بلدية تا روت عام 1955 - الصورة: MT
أتذكر بداياتي المهنية، كنتُ مراسلًا متدربًا، أحمل مسجلًا قديمًا، وأقود دراجة نارية معطلة تحت شمس الظهيرة عائدًا إلى القاعدة. في ذلك الوقت، كانت الصحافة بالنسبة لي مهنةً برّاقة، فقد سافرتُ كثيرًا، وتعرفتُ على العديد من الناس، ودُعيتُ صحفيًا. ولكن، كلما تعمقتُ في المهنة، ازداد فهمي لما يخفيه العمل الصحفي من ضغوط ومخاوف، بل ومخاطر أحيانًا.
كان أول ما كتبتُه مقالاً عن أم فقيرة في قرية تام كيه، التابعة لبلدية هاي كيه، بمقاطعة هاي لانغ. كان انطباعي الأول هو الفقر المدقع الذي تعيشه منطقة ساحلية نائية على رمالها الحارقة. لم يكن للأم المسكينة سوى ابن واحد أعزب. في أحد الأيام، ذهب لصيد السمك ولم يعد. كانت ترقد ملتفة في زاوية خيمة بلا سقف، ملفوفة ببطانية رقيقة ممزقة.
- هل أكلت بعد؟ سألت.
وبعد لحظة همست: لقد نفد الأرز لدينا منذ ثلاثة أيام يا عمي!
ذهبتُ إلى صندوق ذخيرة الرشاش القديم الذي كانت تستخدمه لتخزين الأرز. عندما فتحته، صدمتُ لرؤية ثماني حبات أرز فقط ممزوجة بالصدأ. كان قاع الصندوق مغطى بآثار خدش. لا بد أنها حاولت طهي دفعة أخرى من الأرز، لكن لم يتبقَّ شيء لإشعال النار. لقد كانت جائعة منذ ثلاثة أيام.
كان مسؤول الجبهة في القرية الذي رافقني مرتبكًا وهو يشرح. لقد عاشت وحيدة لسنوات طويلة، بلا أقارب. كان الجيران يساعدون أحيانًا بالوجبات وحزم الخضراوات، لكن في بلد يعاني من شحّ كبير، لا يدوم اللطف إلا لفترة قصيرة. أخرجتُ محفظتي وأعطيتها كل المال، وعندما عدتُ، نفد وقود دراجتي النارية في منتصف الطريق، واضطررتُ للسير أكثر من 5 كيلومترات قبل أن أستخدم هاتف مركز حرس الحدود للاتصال بزملائي طلبًا للمساعدة.
بالعودة إلى مكتب التحرير، كتبتُ المقال بثقلٍ كبير. نُشر المقال على الصفحة الأولى، مع صورةٍ لها وهي مُكدّسة تحت سقفٍ مُمزّق، تنظر عبر الغيوم والسماء. بعد يومين فقط، وصلتني عشرات المكالمات الهاتفية، من أشخاصٍ في هوي، ودا نانغ، وصولًا إلى هانوي وسايغون. قدّمت جمعيةٌ خيريةٌ الأرز والبطانيات وحتى المال للمساعدة. بكت، وبكيت أنا أيضًا. كانت تلك أول مرةٍ أرى فيها قلمي يُدخل البهجة على قلب إنسان. وتعلّمتُ أيضًا شيئًا جديدًا. الصحافة، حين تُلامس حياة الناس، مؤلمةً أحيانًا، وتُؤثّر فيهم، وتُروي القصة بكل صدقٍ واحترام، دون تجميل، دون إثارة، دون تهرّب، تُحقّق فعاليةً حقيقية.
كانت مقالة الأم في ثام كي نقطة انطلاق رحلتي التي استمرت ٢٣ عامًا. لاحقًا، سافرتُ عبر بلدان عديدة، وقابلتُ عددًا لا يُحصى من الأرواح، لكن شعور الوقوف أمام صندوق الذخيرة الفارغ ذاك، الذي يحتوي على ٨ حبات أرز، لا يُنسى أبدًا.
لكن الصحافة لا تخلو من لحظات مؤلمة. هناك مقالات تعكس آراءً سلبية، رغم التحقق منها بدقة، لكنها تتحول دون قصد إلى أدوات لحسابات استغلالية. ما زلت أتذكر بوضوح حالةً بدت جلية. عندما تلقينا تعليقات من أشخاص حول تعرضهم للقمع في مزاد لأحواض الروبيان والأسماك في إحدى البلدات الساحلية، توجهنا فورًا إلى المنطقة للتحقق.
القصة كالتالي: نظمت حكومة البلدية مزايدةً لمساحة بحيرة تبلغ مساحتها حوالي هكتارين لتربية الأحياء المائية. سارت المزايدة بسلاسة حتى إعلان النتائج، وفاز بها صاحب أعلى سعر. لكن بعد فترة وجيزة، اكتشف البعض أن سعر الوحدة كان ناقصًا، مما جعل السعر الفعلي أقل بكثير.
وفقًا للوائح، يُعتبر العرض المُسجّل خطأً باطلاً، وتُعتبر الوحدة التالية ذات السعر الأقل هي الفائزة. إلا أن الأمر المثير للجدل هو أن الفرق بين الوحدتين يصل إلى مئات ملايين الدونغ. أعلنت حكومة البلدية، تحت ضغط "خسارة أصول الدولة"، إلغاء النتائج وإعادة تنظيم المزايدة. ومن هنا بدأت سلسلة من الشكاوى والتظلمات بين الوحدة الفائزة الأصلية واللجنة الشعبية للبلدية.
شاركنا في الأمر، والتقينا بالعديد من الجهات المعنية، وراجعنا الوثائق القانونية بعناية، وخلصنا إلى أن منح العقد للوحدة التي حصلت على المركز الثاني بعد استبعاد الوحدة الأولى كان متوافقًا تمامًا مع اللوائح. وتحت ضغط جهات عديدة، بما في ذلك الصحافة، اضطرت حكومة البلدية أخيرًا إلى الاعتراف بالنتيجة.
ظننتُ أن القضية انتهت. لكن بعد عام، وفي ظهيرة يوم جاف، جاء ثلاثة مزارعين إلى منزلي ومعهم كيلوغرامان من الروبيان المبكر. قدّموا أنفسهم على أنهم من فازوا بعقد مزرعة الروبيان ذلك العام، وجاؤوا ليقدموا لي هدية صغيرة شكرًا للصحفي على مساعدته. لكن بعد بضع محادثات، شعرتُ أن هناك خطبًا ما. وبعد الكثير من الاستجواب، اعترفوا أخيرًا بأن المزاد برمته كان مجرد دراما.
في الواقع، تواطأ المزايدين المشاركان مسبقًا. أحدهما قدم عرضًا مرتفعًا للغاية، وتعمد كتابة صفر ليتم استبعاده، مما مهد الطريق للمزايد الآخر الذي قدم سعرًا أقل بكثير للفوز بالعرض "قانونيًا". كان السيناريو مُعدًّا بذكاء لدرجة أن حتى مسؤولي البلدية، عندما اكتشفوا بوادر مخالفات، لم يجرؤوا على فعل أي شيء بسبب الضغط الشعبي، بما في ذلك الصحافة.
نحن الكُتّاب وقعنا في فخّ دراما مُدبّرة بعناية، حيث تُحوّل الحقيقة إلى أداة للربح. درسٌ مؤلم، ليس فقط في المهنة، بل في الثقة أيضًا.
أتذكر بوضوح شديد شعور الارتباك الذي انتابني وأنا أقف أمامهم، مزارعين يبدون بسطاء، لا تزال أيديهم تفوح منها رائحة الطين. كانت كل كلمة منهم بمثابة سكين يقطع ثقتي المطلقة بالنزاهة التي ورثتها منذ دخولي المهنة. اتضح أن حسن النية يمكن استغلاله، وأن الثقة يمكن أن تصبح أيضًا مجالًا للحسابات الأنانية.
في صباح اليوم التالي، جلستُ لأدوّن كل ما حدث، ولكن هذه المرة ليس لنشره، بل للتعبير عن مشاعري فقط. لأنني كنت أعلم أنني إن واصلتُ عرضه على العامة، فقد أُثير، دون قصد، دوامة جديدة من الجدل والألم والشك. كان عليّ أن أتعلم اختيار الوقت المناسب للتحدث، والطريقة الصحيحة لقول الحقيقة. لأن الحقيقة لا تُقبل دائمًا كما هو مرغوب. أحيانًا يتطلب الأمر الصبر والتحضير وشجاعة الانتظار.
من تلك القصة، غيّرتُ أسلوب عملي. فكل معلومة أتلقاها من الناس، مهما بدت عاطفية ومفصلة، أُدقّق فيها مرارًا وتكرارًا. ليس فقط بمقارنتها بأقوال المسؤولين المكتوبة أو المنطوقة، بل أيضًا بوضعها في سياق أوسع للعلاقات، والتاريخ المحلي، والدوافع الخفية وراءها.
منذ ذلك الحين، أصبحنا أكثر حذرًا عند الانحياز لأحد. ليس الأمر أن الصحافة فقدت دعمها للمستضعفين، بل لحماية الأشخاص المناسبين الذين يحتاجون حقًا إلى الحماية. وأحيانًا أيضًا لحماية شرف الصحافة، الذي استخدمه الانتهازيون درعًا في كثير من الأحيان.
سألني أحدهم. بعد تلك الحادثة، هل كنتَ خائفًا؟ أجبتُ دون تردد. نعم. خائفًا من الخطأ. خائفًا من التلاعب. ولكن قبل كل شيء، خائفًا من إيذاء الشرفاء. وتعلمتُ درسًا قيّمًا وهو أن الصحفي لا يحتاج فقط إلى قلمٍ حاد، بل أيضًا إلى عقلٍ رصين وقلبٍ واعٍ. الحقيقة ليست دائمًا ما تُرضي الأغلبية. وأحيانًا، لا يكون الصواب ما يُرضي الجميع.
بالنظر إلى الماضي، لم يكن ذلك الحادث مجرد فشل في كتابة مقال، بل كان أيضًا فشلاً في الإيمان والضمير. لكن منذ تلك اللحظة، سلكنا طريقنا بثبات ومسؤولية وتواضع أكبر في مهنتنا. لم نعد نتمسك بعقلية "كشف الحقيقة مهما كلف الأمر"، بل سعينا وراء الحقيقة بروح من الإنصاف والرصانة والفهم الكافي لتجنب الوقوع في الحسابات الخفية.
منذ ذلك الحين، كلما أمسكت بقلمي لأكتب عن قصة سلبية، أسأل نفسي: هل هذا صحيح؟ أسأل نفسي أكثر فأكثر. من وراء هذه القصة؟ وهل نُجرّ إلى لعبة أخرى لا نعرفها؟
خلال ثلاثة وعشرين عامًا من العمل الصحفي، مررتُ بكل التقلبات، من أفراح تبدو صغيرة لكنها مؤثرة للغاية، إلى خيبات أمل مؤلمة تدفعني إلى التأمل في نفسي. أحيانًا يصبح القلم جسرًا للحب، وأحيانًا سلاحًا ذا حدين إن لم يُمسك بشجاعة ويقظة.
مع ذلك، أؤمن دائمًا برسالة الصحافة النبيلة، وهي رحلة البحث عن الحقيقة، لا بغطرسة من يحمل ميزان العدالة، بل بقلبٍ يُنصت، ويُشكك حتى في مشاعره الخاصة، حتى لا يُصبح أداةً لغيره. الآن، وقد شَبَ شعري، ما زلت أشعر برعشةٍ في قلبي كلما صادفتُ قصةً تستحق أن تُروى.
ربما لأن الدافع الذي يجعل الناس يستمرون في ممارسة الصحافة طيلة حياتهم ليس الهالة، ولا اللقب، بل اللحظة التي يرون فيها حياة شخص ما، حدثاً مضاءً بنور الضمير.
مينه توان
المصدر: https://baoquangtri.vn/vui-buon-nghe-bao-chuyen-ke-sau-23-nam-cam-but-194443.htm






![[صورة] صورة مقربة لمحطة الطاقة الكهرومائية لنهر با ها تعمل على تنظيم المياه المتجهة نحو مجرى النهر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F25%2F1764059721084_image-6486-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[صورة] رئيس الوزراء فام مينه تشينه يستقبل حاكم محافظة غونما (اليابان) والمستشار الخاص للتحالف البرلماني للصداقة اليابانية الفيتنامية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F25%2F1764066321008_dsc-1312-jpg.webp&w=3840&q=75)










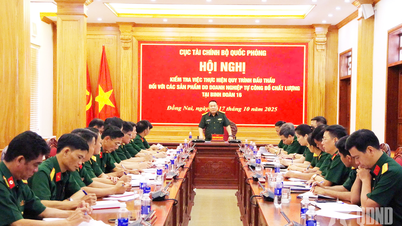






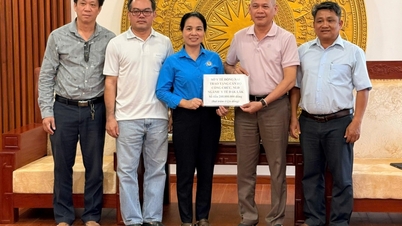






























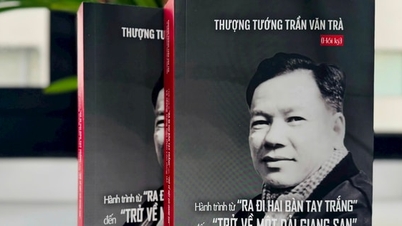






![[إجابة] هل يجب تركيب مصعد لمنزل قديم مجدد؟](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/25/1764039191595_co-nen-lap-thang-may-cho-nha-cai-tao-cu-khong-04.jpeg)










































تعليق (0)