في الماضي، كلما ذكّرتني أمي بإحضار هذا أو ذاك، كنتُ أنزعج وأجادلها قائلًا: "لقد كبرتُ يا أمي، لا داعي للقلق". أما الآن، ففي كل مرة أسمع فيها تذكيرها لي، أبتسم في سري، وقلبي يفيض بالمودة والسعادة. لأن أمي ما زالت بجانبي تُريحني، وتُحبني، وأتلقى منها الرعاية - أمور قد تبدو بسيطة، لكنها تُمثل عالمًا كاملًا من الحب الذي تُكنّه لأبنائها.
بالنسبة للكثيرين، السعادة مرتبطة بالأمور العظيمة. أما أنا، كامرأة دخلت الأربعينيات بعد تقلبات كثيرة في حياتي، فقد بدأت أفكر بشكل مختلف: السعادة تنبع من الأشياء البسيطة، من تلك اللحظات الصغيرة في الحياة، من تلقي الحب ومنح الرعاية التي أكنّها لأحبائي. إنها تلك العطلات الأسبوعية التي أعود فيها مع أطفالي إلى منزل والدتي، حيث أحتفظ بذكريات طفولة جميلة مع والديّ، ومع أختي الكبرى التي كانت دائماً مستعدة لمنحني كل ما أريد، ومع أخي الأصغر الذي كان دائماً يتمنى مرافقتها إلى المدرسة...
كان العودة إلى المنزل تعني الجلوس مع أمي على الدرجات القديمة البالية، الملطخة بالطوب الأحمر المصفر والمغطاة بالطحالب. تلك الدرجات تحمل آثار خطواتنا الأولى المترددة، المفعمة بتشجيع والدينا. كانت الفرحة غامرة والتصفيق لا ينتهي عندما خلعت أختي الصغرى، لأول مرة، عكازيها ومشت على قدميها - بعد أن أصيبت بشلل الأطفال في طفولتها. بكى أبي كطفل، فرحًا في تلك اللحظة، لأن إنجاز أختي الصغرى كان بفضل مثابرته وصبره. رافقها كل يوم، يقدم لها التشجيع والدعم ليمنعها من الاستسلام. كان أيضًا سندًا قويًا، كتفًا تستند إليه أمي، مانحًا إياها الإيمان بأن أختي الصغرى قادرة على النجاح، خاصة عندما رأت دموعها وسقوطها، وقدميها تنزفان...
على عتبة ذلك الباب القديم نفسه، كنا نجلس أنا وأخواتي، ننتظر عودة والدينا من العمل، متمنين الحصول على هدية صغيرة من جيب قميص أبينا البالي. أحيانًا كانت حلوى جوز الهند المطاطية، وأحيانًا أخرى حلوى الحليب الطرية، ومن ذلك الجيب، ما زلت أشم رائحة العرق النفاذة بعد يوم من حمل أكياس الملح الأبيض النقي، المالح بنكهة البحر، إلى المخزن. على عتبة ذلك الباب الصغير نفسه لمنزلنا الخشبي ذي الغرف الثلاث والسقف القرميدي، شعرت بالحب الذي لا حدود له، والتضحية الصامتة والعظيمة والدائمة التي قدمها والداي لأبنائهما الصغار...
كان العودة إلى منزل أمي يعني الانضمام إليها في الحديقة لقطف الخضراوات البرية وطهي وعاء صغير من الحساء مع بعض الروبيان المجفف. لاحظتُ أن خطواتها لم تعد رشيقة كما كانت، وأن ظهرها أكثر انحناءً، وهي تجلس في زاوية الحديقة. استمتعتُ بطهي السمك معها في قدر فخاري قديم في المطبخ الذي يعمل بالحطب، والذي تفوح منه رائحة الدخان النفاذة. انضممتُ إليها في إشعال النار الدافئة، واجتمعت العائلة بأكملها حول وجبة بسيطة، لكنها كانت تفيض بالحب. على تلك المائدة المتواضعة، كانت أمي تروي قصصًا من الماضي، قصصًا لم تكن مملة ولا مبتذلة كما كنتُ أظن. حتى يتمكن أبناؤها وأحفادها من تذكر جذورهم، وتذكر أجدادهم من جهة الأم والأب من تلك السنوات المتواضعة عندما كان آباؤهم في نفس عمرهم الآن.
أليس العودة إلى الوطن الحبيب دائمًا أبسط الرحلات وأروعها في قلب كل إنسان؟ سواء أكانت العودة فكرية أم عملية، فهي دائمًا مصدر سعادة. تهدأ عواصف الحياة خلف الباب. إنها سعادة تنبع من الأشياء البسيطة والعادية. إنها فهم لماذا، بعد كل عودة إلى حضن الحب، تسترجع الأم ذكريات الماضي. ذلك لأن شعرها قد شاب، والتجاعيد حول عينيها تزداد عمقًا يومًا بعد يوم، ولم يعد لديها متسع من الوقت للمستقبل.
فام ثي ين
المصدر: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202510/ve-nha-hanh-trinh-tuyet-voi-cua-trai-tim-6961c3a/






















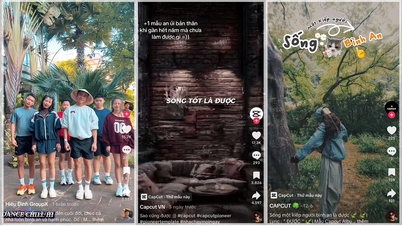










![[إنفوغرافيك] صورة للجنة الدائمة لرابطة مزارعي مقاطعة دونغ ناي للفترة 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/14/1765708210139_thumbnail_ban_thuong_vu_sua_20251214164836.jpeg)











































































تعليق (0)