منذ صغري، عشتُ في كنف جدّي وجدّتي الحنونين. كان منزل جدّي وجدّتي يبعد حوالي خمسة كيلومترات عن منزلي. كان والدي يعمل بعيدًا ولا يعود إلى المنزل إلا مرة واحدة في السنة. أما والدتي فكانت تُدرّس في المدرسة، وتعتني بإخوتي الصغار، وتقوم بأعمال المنزل، لذلك عندما كنتُ طفلاً، كانت والدتي تسمح لي غالبًا بالبقاء في منزل جدّي وجدّتي.
كنتُ أكبر الأحفاد، وكان جدّاي لا يزالان شابين، لذا كان الجيران يمزحون غالبًا قائلين إنهما ربّيا طفلًا رضيعًا. في منزل جدّي وجدّتي لأمي، كنتُ أركب عربة يجرّها ثور، وأصطحبهما في كل مكان: لقطف الفول السوداني في حقل تشوا، وحصاد الأرز في الوادي... ما زلتُ أتذكر أن وجودي كان يُسعد جدّي وجدّتي طوال اليوم، لأنني كنتُ أتحدث وأضحك وأطرح أسئلة عن كل شيء، ولم ينتهوا من الإجابة أبدًا.
كان منزل جدّي وجدّتي لأمي، كبيره وصغيره، مبنيًا من الطين. لم تكن الكهرباء متوفرة آنذاك، وكانت مصابيح الزيت تومض كل ليلة، لكنني لن أنسى أبدًا تلك الوجبات البسيطة التي كنت أتناولها معهما. في أمسيات الصيف الحارة، كانت جدّتي تأخذ الصينية إلى الفناء لتناول الطعام، مستمتعةً بنسيم العصر العليل. أتذكر طبق الموز الأخضر الذي كانت جدّتي تطبخه مع الفول السوداني المطحون، وتضيف إليه بعض الأعشاب المقطوفة من الحديقة، ثم تغمسه في صلصة غنية وحامضة. ستبقى تلك الوجبة محفورة في ذاكرتي إلى الأبد.
كل ليلة، كانت اليراعات تومض في أرجاء الحديقة، متلألئة كأنها في حكاية خيالية. كان جدي يمسك ببعضها ويضعها في مرطبان زجاجي لألعب بها. ولما رأى حفيدته تستمتع بضوء اليراعات، شعر بسعادة غامرة. في ليالي الصيف المقمرة، حين تتساقط أزهار الأريكا على أوراق الموز، كنت أتبع جدتي لأجلس في الشرفة وأستمتع بنسيمها العليل. كنت أستلقي ورأسي على ركبة جدتي، أستمتع بنسيم مروحة سعف النخيل التي كانت ترفرف، وأستمع إلى جدتي وهي تروي حكايات قديمة، حتى غفوت دون أن أشعر. وفي أحد الأيام، استلقيت بجانب جدي، أستمع إليه وهو يقرأ حكاية كيو. ورغم أنني كنت صغيرة ولم أفهم شيئًا، إلا أن مجرد سماع إيقاع الأبيات كان يُسعدني كثيرًا، فأنصت باهتمام. لاحقًا، عندما كبرت، علمت أنه كان معلمًا، ولذلك كان مُلِمًّا بالشعر إلمامًا واسعًا.
شعور السلام الذي ما زلتُ أفتقده هو ليالي المنزل الصغير، بضوئه الخافت، وصوت راديوه الذي يعمل بالبطارية وهو يبثّ الأغاني الشعبية. في أيام السبت، كان يُبثّ برنامج "اليقظة"، وكان ينتظر بفارغ الصبر برنامج "مسرح الراديو". ما زلتُ أذكره جالسًا إلى الطاولة يحتسي كوبًا من الشاي الأخضر، ويأخذ نفخة من التبغ، ثم يُغمض عينيه نصف إغماضة ويقول: "حاول أن تدرس جيدًا، فغدًا ستعمل مثل السيدات والسادة في محطة الراديو". ما إن ينتهي من كلامه، حتى يتردد صدى صوت الجيتار في أذني، لكن روحي تُحلّق بجناحيها مُتبعةً أحلامًا بعيدة كما كان يتمنى.
أحيانًا، عندما كنتُ معه، كان يُداعب شعري ويقول: "عندما تصلين إلى الصف السابع، يمكنكِ ركوب دراجتكِ إلى منزل جدّيكِ وحدكِ، دون أن تطلبي من والدتكِ أن تُقلّكِ!". وهكذا، وبسرعة، وصلتُ إلى الصف السابع، ولأول مرة، سمحت لي والدتي بركوب دراجتي لزيارة جدّي وجدّتي. ولكن في ذلك الوقت أيضًا، اكتشفت عائلتي أنه مريضٌ مرضًا خطيرًا. أتذكر أنه في أيامه الأخيرة، لم يتخلَّ عن هوايته في الاستماع إلى الراديو، وكان لا يزال يقرأ لي الشعر كل ليلة.
الآن، وبعد مرور ما يقارب العشرين عاماً على وفاته، ما زالت جدتي على قيد الحياة، وقد تجاوزت السبعين من عمرها. ورغم كبر سنها، إلا أن ذاكرتها ما زالت حاضرة، وخاصة القصص التي ترويها عنه، فهي لا تزال ترويها بوضوح وبمشاعر جياشة وكأنها ما زالت حية.
كبرت، وسافرت بعيداً، وفي كل مرة أعود فيها لزيارة جدتي، كنت ألازمها: أطبخ الأرز، وأجلب الماء، وأقطف لها الخضراوات، لأكون معها مجدداً، في دفء وسلام. كنت أسمي ذلك سعادة الحياة.
في فونغ
المصدر: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/ben-ngoai-la-hanh-phuc-ded0f5c/






![[صورة] استكشف السفينة الحربية يو إس إس روبرت سمولز التابعة للبحرية الأمريكية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F10%2F1765341533272_11212121-8303-jpg.webp&w=3840&q=75)














































































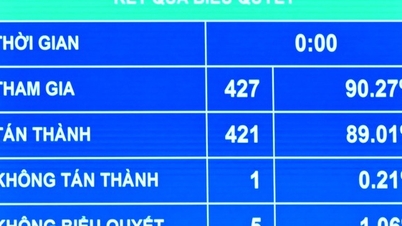































تعليق (0)